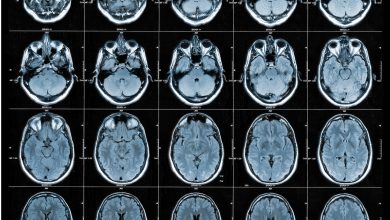الطرقُ المذهلةُ التي يؤثر بها المكان الذي تعمل فيه في أدائكَ
دماغك المبهر حساسٌ لما يحيط بك، إذ يستوعبُ الإشارات والمشتتات الخارجية سواءً أأعجبَك ذلك أم لا. يمكن أن يؤدي فهم كيفية حدوث ذلك إلى تغيير طريقة عملنا

في صيف عام 2001 كانت سابنا شيريان Sapna Cheryan خريجةً جديدةً تجري مقابلاتٍ للحصول على فترة تدريبٍ في شركات التكنولوجيا في منطقة خليج كاليفورنيا California’s Bay Area. وتستذكرُ أنّ مكان العملِ في إحدى الشركات بدا كأنه استراحةٌ في الطابق السفلي لمكان إقامة شخصٍ شغوفٍ بالحاسوب، مملوءاً بشخصياتِ الرسوم المتحركة وبنادق النيرف Nerf gun، إضافةً إلى نموذج علبة مشروب صودا عليها رسمة جسر غولدن غيت (البوابة الذهبية) Golden Gate Bridge. بدا لها هذا كله أنه مصممٌ لدعم مفهومِ الموظف المثالي في الشركة. بصفتها امرأةً شابةً سمراء، شعرتْ بأنها غير مرحبٍ بها، بل بأنها غريبةٌ. قبلَتْ مكاناً في شركةٍ أخرى ـ مكان عملٍ بهيجٍ وجذاب.
بعد خمسة أعوام انتقلَتْ شيريان إلى جامعة ستانفورد Stanford University في كاليفورنيا California لبدء أبحاث رسالة الدكتوراه لاستقصاء كيفية تأثير الإشاراتِ المادية في بيئتنا بطريقة تفكيرنا وشعورنا. وهي من بين عددٍ متزايدٍ من الاختصاصيين بعلم النفس المعرفي Cognitive scientist الذين تتحدى أبحاثهم فكرة أن الدماغ مثل الحاسوب. لا تبالي الحواسيب بمحيطها: يعمل الحاسوب المحمول في مكتبٍ مضاءٍ بالفلوريسنت بالطريقة نفسها التي يعمل بها في حديقةٍ مورِقَةٍ. فلا ينطبق الشيء نفسه على الدماغ البشري. في الواقع، وجدت شيريان وآخرون أن أداء الدماغ البشري باهر وحساسٌ للسياق الذي يعملُ فيه.
يبدو هذا البحث وثيقَ الصلة في هذا الوقت تحديدا. فأثناء الجائحة Pandemic، أُجْبِرَ الكثير منا فجأةً على العمل والتعلم في بيئاتٍ مختلفةٍ، وصارَ تأثير المكان في المعرفة موضعَ تركيزٍ حادٍ. وبما أن البعض منا قد عاد إلى المكاتب والمدارس، فإن لدينا فرصةً لإعادة تصور هذه الأماكن وفقاً لما تعلمه الباحثون. فإذا اغتنمناها، سنتمكن من إجراء بعض التغييرات الكبيرة.
مُسْتَلْهِمَةً من تجاربها الشخصية، يركزُ بحث شيريان على جانبٍ معينٍ من البيئة المادية، وهو ما يسميه الاختصاصيون بعلم النفس إشارات الانتماء Cues of belonging. فهذه إشاراتٌ مُضَمَنَةٌ في المكان تخبرُ القاطنين بأنه مرحبٌ بهم هناك ـ أو غير مُرَحَبٍ بهم. ففي إحدى التجارب استخدَمَتْ شيريان وزملاؤها مكاناً في مبنى علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد، وأنشؤوا ما أطلقوا عليه اسم فصلٍ دراسي نمطي وفصلٍ دراسي غير نمطي. كان الأول مملوءاً بملصقاتِ مسلسل الخيال العلمي ستار ترك Star Trek وأفلام حرب النجوم Star Wars، وكتب الخيال العلمي، وعلب المشروبات الغازية. احتوى الآخر على ملصقاتٍ عن الطبيعة، ورواياتٍ أدبيةٍ، وزجاجاتِ مياه.
بعد بضع دقائق فقط في الغرفة النمطية أعرب الطلاب الجامعيون الذكور عن مستوى عالٍ من الاهتمام بمتابعة علوم الحاسوب. وكانتْ الطالباتُ أقل اهتماماً. ولكن اهتمامهن ازداد ازدياداً ملحوظاً، وتجاوز فعلياً اهتمام الرجال، بعد قضاء بعض الوقت في الغرفة غير النمطية. ووجد بحثٌ لاحقٌ أجرته شيريان أن الطالباتِ اللاتي درسن في فصولٍ دراسيةٍ افتراضيةٍ غير نمطيةٍ كان من المرجح أكثر أن يتوقَعن أنهنّ سيحققن أداءً جيداً في دورات علوم الحاسوب من أولئك اللاتي درسن في فصولٍ نمطيةٍ. أما الطلابُ الذكور؛ فمالوا إلى توقع نجاحِهم بغض النظر عن نوع الغرفةِ . هذا مهمٌ. قالتْ شيريان في حديثٍ في تيد إكس TEDx: “نعلم من دراساتٍ سابقةٍ في علم النفس أن مقدار توقعِك لجودة عملك في بيئةٍ معينةٍ يمكن أن يحددَ فعلاً جودة أدائك”.
شيريان التي تعمل الآن في جامعة واشنطن University of Washington بسياتل تُسَمي هذه الظاهرة بــ “الانتماء المحيطي” Ambient belonging، وتعتقدُ أننا نطور سريعاً هذا الإحساس بالاندماج أو عدمه “حتى بنظرةٍ خاطفةٍ على عددٍ قليلٍ من الأشياء”. ففي الآونة الأخيرة استكشفَتْ كيف يمكن تصميم الأماكن لجعل مجموعةٍ أكبر من الأشخاص يشعرون بالانتماء. وتؤكد أن المفتاح ليس القضاءَ على الصور النمطية، بل تنويعها ـ لنقل رسالةٍ مفادِها أن الأشخاص من خلفياتٍ مختلفةٍ يمكن أن ينجحوا في محيطٍ معينٍ. وانطلاقاً من هذه الفكرة، فقد جَدَّدَتْ جامعتُها مُخبترَ علوم الحاسوب، وذلك بطلائه بطلاءٍ جديدٍ، وتعليقِ مجموعةٍ متنوعةٍ من الأعمال الفنيةِ، وترتيب المقاعد ترتيباً يُشَجِعُ على تفاعلٍ اجتماعي أكبر. وبعد خمسة أعوام ارتفعَتْ نسبة الشهادات الجامعية التي حصلَتْ عليها النساء هناك في علوم الحاسوب إلى 32% ـ وهي نسبةٌ أعلى من أي جامعةٍ عامةٍ رائدةٍ أخرى في الولايات المتحدة.
لمساعدة الأشخاص على التفكير تفكيراً فعالاً، لا يحتاجُ مكان العمل إلى إشاراتِ الانتماء فقط، بل إلى إشارات الهوية أيضاً. فهذه علاماتٌ وإشاراتٌ ملموسةٌ نرتبها حولنا لدعمِ تصورنا عن أنفسنا. إنها تفعل أشياء كالإعلان عن شغفنا، وهواياتنا، وإنجازاتنا، أو تعبرُ عن خصلةٍ إبداعيةٍ أو حس دعابةٍ غريبٍ، أو تذكرُنا بأحبائنا. ومثل هذه التعبيرات أحياناً تهدف إلى إعلام الآخرين بمن نحن، أو من نود أن نكون، ولكنها غالباً ما تكون موجهةً إلى جمهورٍ مُقَرَبٍ أكثر: أنفسنا. عندما فحص الباحثون أماكن عمل الأشخاص في مجموعةٍ متنوعةٍ من الوظائف، من المهندسين ووكلاء العقارات، إلى مُخَطِطي الفعاليات والمديرين المبدعين، وجدوا أن نحو ثلث إشاراتِ الهوية كانت مرئيةً لأصحابها فقط. وارتفعَتْ هذه النسبة إلى 70% بالنسبة إلى الأشياء التي كان الغرضُ المُعْلَنُ منها تذكيرَ أصحابِها بالأهدافِ والقيمِ الشخصية.
لماذا نحتاج إلى مثل هذه التذكارات؟ قد يبدو إحساسنا بالذات ثابتًا Stable وصلبًا Solid، لكنه في الواقع مائعٌ Fluid ومعتمدٌ في شكله على العالم الخارجي إلى حدٍ ما. عادةً ما يعاني الأشخاص هذا حين يسافرون إلى بلدٍ أجنبي، حيث يمكن أن تخلقَ البيئةُ غير المألوفة إحساساً ممتعاً ولكنه مُرْهِقٌ بالارتباكِ. في حياتنا اليومية، نحتاجُ إلى تنميةِ إحساسٍ مستقرٍ بالهوية للعمل بفعالية، والأشياءُ الشخصية التي نضعها حولنا تساعدنا على تحقيق ذلك.
تؤدي إشارات الهوية دوراً آخر أيضاً. ليست لكل واحد منا هويةٌ واحدةٌ فقط بل العديد من الهويات، مثل العاملِ، أو الطالب، أو الأخ، أو الزوج، أو الوالد، أو الصديق. وتقول عالمة النفس دافنا أويزرمان Daphna Oyserman، من جامعة جنوب كاليفورنيا University of Southern California، إن الإشاراتِ من البيئة التي نوجد فيها تعملُ على إبراز إحدى هذه الشخصيات، ولهذا تأثيراتٌ فعليةٌ في تفكيرنا وسلوكنا. ويشيرُ بحثها إلى أن أي هويةٍ بارزةٍ في لحظةٍ ما تؤثرُ في كل ممّا ننتبه له وما نختار فعله. في مثالٍ صارخٍ على ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن الإشارات التي تذكر الفتيات الأمريكيات الآسيويات بعرقهن أدت إلى تحسين درجاتهن في اختبارات الرياضيات، بينما ضعضَعَتْ الإشارات التي تذكرهن بجنسهن أداءَهن. وبالنسبة إلينا جميعاً، فإن الأشياء التي تقعُ عليها أعيننا كل يومٍ تعزز ما نفعله في ذلك المكان، في ذلك الدور Role.
تتعلق إحدى السمات ذات الصلة بمكان عملنا بالشعور بالملكية. عندما ندخل إلى مكانٍ يبدو أنه ملكنا، تنشأ عن هذا مجموعةٌ من التغييرات النفسية وحتى الفيسيولوجية. لوحظت هذه التأثيرات لأول مرةٍ في دراسات أفضلية الأرض Home advantage، وهي ظاهرة ميل الرياضيين إلى تحقيق انتصاراتٍ أكثر وأكبر حين يلعبون على أرضهم، وملعبهم، وأمام مدرجهم. وتشير الدراسات إلى أن الفِرَقَ في أرضها تلعبُ لعباً أكثر اندفاعاً ويظهرُ أعضاؤها (ذكوراً وإناثاً) مستوياتٍ أعلى من هرمون التستوستيرون Testosterone، وهو هرمونٌ مرتبطٌ بالتعبير عن الهيمنة الاجتماعية. ولكن أفضلية الأرض لا تقتصر على الرياضة. إذ اكتشف الباحثون أنه حين يكون الأشخاص في مكانٍ يعتبرونه خاصاً بهم، فإنهم يشعرون بأنهم أكثر ثقةً بالنفس وقدرةً. كما أنهم يكونون أكثر كفاءةً وإنتاجيةً، وأقل تشتتاً، ويعزّزون مصالحهم بقوةٍ وفعاليةٍ أكبر.
لدى بنيامين ماهِر Benjamin Meagher، من كلية هوب Hope College بولاية ميشيغان، فكرةٌ مثيرةٌ للاهتمام لشرح ذلك: المكانُ بحد ذاته يساعدُنا على التفكير. ويشير بحثه إلى أن عملياتنا العقلية والإدراكية تعمل بكفاءةٍ أكبر على أرضنا، حيث تكون هناك حاجةٌ أقل إلى ضبط النفس المُجْهِدِ. يفترض ماهِر أن العقل يعمل عملا أفضل لأنه لا يقوم بالعمل كله ـ إنه يحصل على مساعدةٍ من البنى المُدْمَجَةِ في بيئته، البنى التي تجمعُ المعلومات المفيدة، وتدعم العادات والروتينات الفعالة، وتكبحُ الدوافعَ غير المنتجةِ. ويجادل في أن معرفتنا موزعةٌ عبر المحيط بكامله.
المكتبُ المُمكَّن
مع الملكية تأتي السيطرة. يؤدي الشعور بالسيطرة على شكل مكان العمل ووظائفه إلى تحسين الأداء أيضاً. أظهر الاختصاصي بعلم النفس كريغ نايت Craig Knight، والذي كان وقتها في جامعة إكستر University of Exeter في المملكة المتحدة ، وأليكس هاسلام Alex Haslam من جامعة كوينزلاند University of Queensland في أستراليا ، مدى قوة هذا التأثير. فقد طلبوا إلى متطوعين أداءَ مجموعةٍ من المهمات في أربع بيئاتٍ مختلفةٍ: مكتبٌ بالحد الأدنى من المواصفات؛ مكتبٌ مزينٌ بالملصقات والنباتات المُؤصَصَةِ؛ مكتب تحكّمَ المشاركون في ترتيبه كما يحلو لهم؛ ومكتبٌ لم يتحكموا فيه، إذ غيّر الباحثون الترتيبَ الذي اختاروه دون موافقتهم.
في المكتب ذي المواصفات الدنيا، كان المشاركون واهنين ولم يستثمروا سوى القليل من الجهد في العمل المخصص لهم. فقد كانوا غير منتجين في المكتب الذي لم يتحكموا فيه أيضاً، كما أبلغوا عن مشاعر سلبيةٍ مثل الغضب والتعاسة. عمل المشاركون بجهدٍ أكبر وكانوا أكثر إنتاجيةً في المكتب الثري بالعناصر التزيينية. ومع ذلك، فقد كان أداؤهم أفضل في المكتب الذي تحكموا فيه، إذ أعمالا أكثر بنحو 15% من المكتب الثري بالعناصر التزيينية، و30% أكثر من المكتب الخالي. مقدارُ هذه التأثيرات كبيرٌ بما يكفي لجعل أصحاب العمل ينتبهون: إن كان المحيطُ مناسباً، فإنه يمكن لثلاثة أشخاص إنجازُ ما ينجزه أربعةٌ تقريباً. إن هذا ذو صلةٍ بأصحاب العمل الذين يُجربون المكاتب غير المحجوزة Hot-desking، إذ لا يكون للعمال مكانٌ مخصصٌ لهم، ولكنهم يحصلون على مكانٍ شاغرٍ ما حين يصلون إلى المكتب.
هناك اتجاهٌ آخر في مكان العمل، وهو المكتب المفتوح Open-plan officeالذي يشكل تحدياً بيئياً إضافياً للتفكير الفعال. فقد تطور الدماغ ليراقب محيطه المباشر باستمرارٍ خشية أن تشيرَ الأصوات أو الحركات القريبة إلى خطرٍ يجب تجنبه أو إلى فرصةٍ تجب اغتنامُها. بعبارةٍ أخرى، يسهلُ تشتيتُ انتباهنا ـ والمكاتب المفتوحة تعج بالمُشَتِتات. ويكاد يكون من المستحيل، على سبيل المثال، منع أنظارنا من التوجه نحو شيءٍ جديدٍ أو متحركٍ. تنجذب أعيننا إلى الوجوه، وتعطي أدمغتنا الأولوية تلقائياً لمعالجتها، حتى حين نحاول التركيز على صفحةٍ أو شاشةٍ. وإضافة إلى ذلك، فإننا نتضايق عاطفيا حين نُحِسُ بأننا مُرَاقَبون. وكل هذه المراقبة المرئية والمعالجة تستهلكُ قدراً كبيراً من الموارد العقلية، مما يترك قوةً دماغيةً أقل لعملنا.
وهناك الضجة. قد يجذب أي صوتٍ انتباهنا، لكن الكلام يشتت انتباهنا لأنه سواءً أأردنا أن نستمع أم لا، فإن أدمغتنا تحاول فهم المعنى. تُعالجُ الكلامَ في الخلفية مناطقُ الدماغِ نفسها التي نستخدمها لفعل أشياء مثل تحليل البيانات أو كتابة تقريرٍ. وتظهر الأبحاث أن هذا يمكن أن يقللِ كثيرا أداءَنا في مثل هذه المهمات. إن نوع المحادثة أحادية الجانب الناتجة من تحدث زميلٍ على الهاتف تشتت الانتباه لأن أدمغتنا تحاول باستمرارٍ أن تتنبأ بلحظة توقف المتحدث أو استئنافه المحادثةَ، وما سيقوله بعد ذلك. اكتشفت لورين إيمبرسون Lauren Emberson، من جامعة كولومبيا البريطانية University of British Columbia في كندا، أن المهارات اللفظية والحركية للأشخاص تَضعُفُ بسماع “أنصاف المحادثات” هذه أكثر مما لو سمعوا طرفي المحادثة.
الأمر الأكثرُ إثارةً للقلق هو اكتشاف أن البيئات المفتوحة ربما لا تعزز فعلياً التفاعلات الإبداعية ـ وهي أحد الأُسس الذي غالباً ما يُسْتَخْدَمُ للترويج لها. ويَستخدمُ الباحثون جهازاً يُسَمى المقياس الاجتماعي Sociometer لقياس أنماط الحركة الجسدية والتفاعل الاجتماعي بين زملاء العمل. فهم يرتدونه حول الرقبة مثل شارة الهوية، وهو يجمع بياناتٍ دقيقةً عمّن يتحدث إلى من وأين ومدة المحادثة. والنتيجة المفاجئة التي توصلوا إليها هي أن احتمال أن يتفاعلَ الأشخاص وجهاً لوجه في المكاتب المفتوحة أقل مقارنةً بأماكن العمل الخاصة.
وفقًا لنموذج “الدماغ المماثل للحاسوب”، لا يجب أن تكون لأي من هذه العوامل البيئية أهميةٌ ـ ولكن لأننا بشرٌ، فهي مهمةٌ. فقد زُعزِعَتْ الطريقةُ التي نستخدم بها أماكننا زعزعةً عميقةً بسبب الجائحةٍ، وما أدتْ إليه من إغلاق المكاتب والمدارس، وحُصِر العديد من الأشخاص في منازلهم لشهورٍ متواصلةٍ. وبعودتنا مرةً أخرى إلى أماكن العمل، ستكون لدينا فرصةٌ لتحسينها: لملئها بإشارات الانتماء والهوية، وغمرها بالإحساس بالملكية والسيطرة، وتوفير المزيد من الخصوصية. باختصار، يمكننا جعلها أماكن أفضل للتفكير.
التفكير الجماعي
الفكر البشري حساسٌ جداً للسياق، وأحدُ أقوى السياقات هو وجود أشخاص آخرين. وقد يبدو التفكير وكأنه نشاطٌ منفردٌ، شيءٌ نفعله وحدنا داخل رؤوسنا، لكن منظوراً ناشئاً في علم الأعصاب وعلم النفس يقترحُ أنه عمليةٌ اجتماعيةٌ أساسيةٍ. ووفقاً لهذا الرأي، فقد تطورَتْ أدمغتنا للتفكير مع الأشخاص، لتعليمهم، للمحاجّة وتبادلِ القصص. نتيجةً لذلك، عندما نفكر اجتماعياً، فإننا نفكرُ تفكيرا مختلفا، وغالباً أفضل مما لو فكرنا بمفردنا.
حتى وقتٍ قريبٍ، فقد أعاقت قيودٌ تقنيةٌ الباحثين الراغبين في استقصاء دور التفاعل الاجتماعي في المعرفة. ويتطلبُ تصويرُ الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي Functional magnetic resonance imaging (اختصاراً: التصوير fMRI) فحصَ الفرد في عزلةٍ عملياً، محصوراً داخل جهاز التصوير MRI. الآن، هذا يتغير. باستخدام تقنياتٍ مثل تخطيط كهربية الدماغ Electroencephalography (اختصاراً: التخطيط EEG) والتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة Functional near-infrared spectroscopy (اختصاراً: التحليل fNIRS)، يمكننا دراسةُ أدمغةِ العديد من الأشخاص أثناء تفاعلهم في محيطٍ طبيعي ـ أثناء عقد الصفقاتِ، أو لعب الألعابِ، أو مجرد التحدث إلى بعضهم البعض. وكشف استخدامُ هذه الأدوات عن أدلةٍ مقنعةٍ على فرضية الدماغ المتفاعل: الفرضُ هو أنّ الأشخاص حين يتفاعلون اجتماعياً، تستخدمُ أدمغتهم عملياتٍ عصبيةً ومعرفيةً مختلفةً عما يحدثُ حين يفكرُ كل شخصٍ من هؤلاء أو يتصرف بمفرده.
على سبيل المثال، قارنتْ دراسةٌ تستخدم التحليل fNIRS نشاطَ الدماغ في الأشخاص الذين يلعبون البوكر ضد شخصٍ آخر أو ضد حاسوبٍ. وكانت مناطق الدماغ المشاركة في توليد “نظرية العقل” Theory of mind-أي استنتاج الحالة العقلية لفردٍ آخر – فعالةً أثناء التنافس مع الإنسان، لكن خاملةً أثناء التباري مع آلةٍ. في الواقع، ولّدَ اللعبُ ضد الإنسان نمطاً مختلفاً تماماً من نشاط الدماغ. إذ فُعِّلَتْ مناطقُ أكثر في الدماغ، وأظهرَتْ درجةً أعلى من الاتصالية مع بعضها البعض.
وجدتْ دراساتٌ أخرى أن مناطق الدماغ التي تشاركُ في التخطيط والترقبِ، وفي الشعور بالتعاطف، تكون أكثر فعاليةً حين نلعبُ ضد إنسانٍ بدلاً من حاسوبٍ. وتظهرُ أيضاً مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة تنبيهاً أقوى حين نلعبُ – خاصةٍ حين نفوز -ضد خصمٍ بشري.
غالباً ما يُنظر إلى الحياة الاجتماعية وحياة العقل على أنهما مجالان متمايزان، أو حتى متعارضان. تقدمُ هذه المجموعة من الأبحاث رؤيةً مختلفةً، رؤيةً تتموضع فيها اجتماعيّةُ جنسنا البشري -التي لا يمكن كبتها- في قلب الذكاء البشري.
بقلم: آني ميرفي بول
ترجمة: د. محمد الرفاعي
© 2021, New Scientist, Distributed by Tribune Content Agency LLC