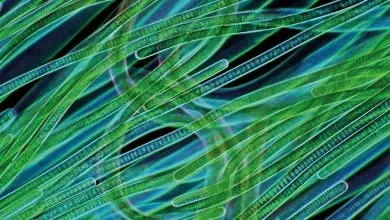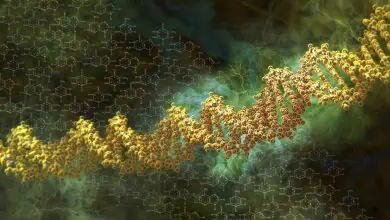شبح الأسلحة البيولوجية
تبدي بعض الدول وبعض المنظمات الإرهابية على حد سواء، اهتماما متزايدا
بالحرب الجرثومية، وهو ما يجب أن يواجَه باتخاذ مزيد من الإجراءات
الصارمة لمراقبة هذا السلاح ومنع استخدامه في شنّ أي هجوم.
<A .L. كول>

خلال حرب الخليج عام 1991 تم تزويد المسافرين في مطار تل أبيب بالأقنعة الواقية من الغازات السامة، وذلك تخوفا من الأسلحة البيولوجية والكيميائية العراقية. |
في أحد أيام سنة 1995 سألت أحد أصدقائي، مازحا، ما الذي يقلقه أكثر، أتعرضه لهجوم بسلاح بيولوجي أم بسلاح كيميائي. فأجابني ساخرا: بصراحة، إن ما يقلقني هو أن أصاب بمرض «الزايمر». وضحكنا معا. لقد تجاهل صديقي بلباقة سؤالي، فهو سؤال غير واقعي لأن الناس في المجتمعات الراقية لا يفكرون في مثل هذه الأمور.
وفي اليوم التالي، أُلقي المركَّب زارين sarin، وهو أحد مركَّبات الأعصاب، في إحدى محطات قطار الأنفاق بمدينة طوكيو، فقُتل من جراء ذلك اثنا عشر شخصا، وأصيب نحو 5500، على الرغم من أن اليابان تعد، من دون شك، واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم. تحدثت في الأمر مع صديقي وتذكرنا معا أمر سؤالي له وكيف كان هذا السؤال في وقته؛ فما يبدو في يوم ما وكأنه تساؤل أو تخمين عابث لا معنى له، قد يغدو في اليوم التالي واقعا جديا قاتلا.
لقد عُزِي سبب عدم مقتل الآلاف في الهجوم الذي شن في طوكيو إلى عدم نقاوة مركّب الأعصاب الذي استخدم؛ ذلك أن قطرة صغيرة من المركب زارين، الذي طوره الألمان للمرة الأولى في الثلاثينات من هذا القرن، تحمل معها الموت خلال دقائق إذا ما لامست الجلد أو إذا ما استُنشق بخارها، حيث يعمل هذا المركب، مثل سواه من مركبات الأعصاب الأخرى، على تثبيط عمل إنزيم (أنظيم) الاستيل كولين استيراز، الذي يؤمِّن نقل التنبهات العصبية.
وقد عمدت الجماعة المسؤولة عن الهجوم بالزارين، وهي الجماعة المعروفة باسم الحقيقة الأسمى Supreme Truth إلى تطوير مركبات بيولوجية أيضا. وإذا كان الهجوم بالسلاح الكيميائي يسبب الرعب والخوف، فإن مجرد التفكير باستخدام سلاح بيولوجي ينشر كوابيس أقسى من الذعر والهلع؛ فالمركبات الكيميائية معدومة الحياة، على خلاف المركبات البيولوجية من جراثيم وڤيروسات وسواها، فهي مركبات حية تتوالد وتتكاثر وتنتشر وتنشر العدوى؛ وهي إذا ما انتشرت في وسط تضاعفت فيه ونمت، بحيث يزداد خطرها مع تقادمها بخلاف أي سلاح آخر.
ومن المركبات البيولوجية ما قد يكون مثبِّطا للهمة ومضعفا للقدرة، ومنها ما يحمل الموت. فڤيروس الإيبولا Ebola مثلا يقتل نحو 900% من ضحاياه خلال أسبوع واحد، حيث يتهتك النسيج الضام ويتمزق، وتنزف كل فتحة (فوهة)arifice في جسم المصاب؛ ويتشنج ضحاياه في المراحل الأخيرة من إصابتهم، وينشرون حولهم دمهم الملوث، ويُصيبهم الارتعاش والترنح إلى أن يلاقوا حتفهم.
ليس للإيبولا دواء أو علاج ولا شفاء منه، كما أن طريقة انتشاره غير واضحة، ولا يُعرف إن كانت الإصابة به تتم بالتماس المباشر مع المصاب أو دمه أو سوائل جسمه أو فضلاته، أو باستنشاق الهواء المحيط به. وقد دَفَعَ تفشيه مؤخرا في زائير إلى اتخاذ إجراءات الحجر الصحي في مناطق واسعة من هذه الدولة إلى أن بلغ هذا الداء مداه.
إن مجرد التفكير بأن أفرادا أو دولا يمكن أن تلجأ إلى استخدام هذا الڤيروس أو سواه في هجوم تشنه على غيرها، أمر يثير الهلع والذعر. وقد توجه <Sh. أساهارا> وهو رئيس جماعة «الحقيقة الأسمى»، في الشهر 10/1992مع أربعين من أتباعه إلى زائير بحجة تقديم المساعدة لعلاج المصابين بالإيبولا. ثم تبين لاحقا، من خلال تقرير نشرَتْه في 31/10/1995 اللجنةُ الفرعية الدائمة لتقصي الحقائق في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الهدف الحقيقي لهؤلاء كان أخذ عينات من ڤيروس الإيبولا وتربيتها وتكثيرها ومن ثم استخدامها في شنّ هجوم بيولوجي.
لم يكن الاهتمام بالحصول على كائنات عضوية فتاكة لاستخدامها لأغراض شريرة، مقتصرا على جهات تعمل في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ففي 5/5/1995، أي بعد ستة أسابيع من حادثة قطار الأنفاق في طوكيو، طلب <L. هاريس>، وهو فني يعمل في أحد مختبرات أوهايو، إلى إحدى الشركات الطبية بولاية ميريلاند، تزويده بالبكتيرة (الجرثوم) التي تسبب مرض الطاعون الدبليbubonic plague؛ وقامت تلك الشركة (وهي المجموعة الأمريكية لاستنبات النماذج في روكفيل (ميريلاند)) بشحن ثلاث قوارير من جراثيم زمرة الييرسينيا YersiniaPestis.
أثار هاريس الشكوك والريبة حوله عندما اتصل بالشركة بعد أربعة أيام من إرسال طلبه متسائلا عن سبب عدم تسلمه ما طلب، فتعجب مسؤولو الشركة من استعجاله وقلة اصطباره وعدم معرفته، على ما يبدو، للتقانات المختبرية، فاتصلوا بالسلطات الفيدرالية وأعلموها بالأمر. وقد تبين لاحقا أن صاحب الطلب عضو في منظمة للمؤمنين بسمو الجنس الأبيض. وقد أدانته إحدى المحاكم الفيدرالية في الشهر 11/1995بتهمة الاحتيال البريدي mail fraud.
وللحصول على بكتيريا الطاعون، لم يكن هاريس بحاجة إلى أكثر من بطاقة اعتماد مصرفية وأوراق رسائل مزورة تحمل في أعلاها اسم مؤسسة ما. ولتجنب تكرار مثل ذلك تم في الشهر 4/1996 سن قانون مضاد للإرهاب يتيح لمراكز مراقبة وتجنب الأوبئة مراقبةً أدق وأوثق لعمليات شحن العوامل المسببة للعدوى.
ولدى سؤال هاريس عما كان يريد أن يفعله بتلك الجراثيم، ادّعى أنه أرادها لإجراء بحوث تهدف إلى القضاء على جرذان عراقية تحمل جراثيم فائقةsupergerms. لكنه لو أرادها لإقامة منشأة بيولوجية تتكاثر فيها الجراثيم، لكانت مهمته على أبسط ما يرام؛ ذلك أن جرثومة واحدة تعطي بانقسامها كل 20 دقيقة، أكثر من بليون نسخة منها خلال عشر ساعات؛ وأن قارورة صغيرة من تلك الكائنات المكروية تستطيع أن تعطي عددا هائلا منها في أقل من أسبوع. ويكفي استنشاق آلاف قليلة من هذه الجراثيم (وهو ما يغطي مساحة أصغر من النقطة التي في نهاية هذه الجملة) لأن يكون قاتلا في حالة بعض الأمراض مثل مرض الجمرة anthrax.
وتذكر السيدة <C .K. بايلي>، المدير المساعد السابق للوكالة الأمريكية لمراقبة ونزع التسلح، أنها قامت بزيارة بضع شركات تهتم بالتقانات الحيوية وبتصنيع منتجات صيدلانية، وتؤكد أنها على «قناعة راسخة» بأنه يمكن إقامة منشأة بيولوجية كبيرة بتجهيزات لا يزيد ثمنها على عشرة آلاف دولار، وفي غرفة لا تتعدى أبعادها 15 × 15 قدما. وخلاصة القول إنه يمكن تنمية وتكثير تريليونات من الجراثيم من دون أي خطر على من يقوم بذلك، وباستخدام تجهيزات ليست أكثر تعقيدا من جهاز تخمير البيرة ومستنبتة بروتينية وقناع ورداء خارجي من البلاستيك.
ولحسن الحظ فإن الحوادث التي اعتمدت الإرهاب البيولوجي كانت محدودة إلى حد كبير، واقتصرت على حالات نادرة جدا. وقع أحد هذه الحوادث في الشهر 9/1984، حيث أصيب نحو 650 شخصا بعد تناولهم طعاما في بعض مطاعم مدينة ذي دالاس بولاية أوريگون. وفي سنة 1986 اعترفت <A .M. شيلا> أمام محكمة فيدرالية، أنها وأعضاء آخرين من إحدى الجماعات الدينية الذين كانوا على خلاف مع السلطات المحلية الأوريگونية، قاموا بنشر جراثيم السالمونيلا في صحون سلطة الخضار في أربعة مطاعم، وأن تنمية تلك الجراثيم جرت في مختبر يقع في مزرعة تملكها الجماعة. وقد حُكم على شيلا، التي كانت مساعدة لرئيس الجماعة <B. راجنيش> بالسجن سنتين ونصف السنة أطلق سراحها بعدها ورُحِّلت إلى أوروبا.

تعتبر جماعة الحقيقة الأسمى اليابانية ڤيروس إيبولا، الذي دُفن ضحاياه في مدينة كيكويت بزائير سنة 1995 في قبور جماعية، سلاحا بيولوجيا محتملا. |
وقد أشار تقرير نَشَره مكتب التقييم التقاني عام 1992 إلى أن اللجوء إلى الإرهاب البيولوجي والكيميائي كان نادرا. كما أن استخدام العوامل البيولوجية كأسلحة حربية كان نادرا أيضا. وربما حصل أول حادث مدون في القرن الرابع عشر حين قام الجيش الذي كان يحاصر مدينة كافّا، وهي مرفأ على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم بروسيا، بإلقاء جثث مصابة بالطاعون من فوق أسوار تلك المدينة. كما قام ضابط بريطاني في أمريكا، المستعمرة البريطانية في ذلك الحين، بتزويد الهنود ببطانيات ملوثة بأعداد كبيرة من الجراثيم حصل عليها من محجر يُحجز فيه المصابون بمرض الجدري smallpox، وذلك حتى ينتشر هذا الوباء بين القبائل الهندية. أما الشاهد الوحيد المؤكد في هذا القرن، فهو استخدام اليابانيين لجرثوم الطاعون وسواه من الجراثيم في حربهم ضد الصينيين في الثلاثينات والأربعينات.
ومع اقتراب نهاية القرن العشرين، بدأت تلوح في الأفق مظاهر تناقض منفّر. فمع تزايد عددِ الدول التي وقّعت الاتفاقات الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يتزايد أيضا عدد الدول التي يُشتبه بأنها تهتم بتطوير هذه الأسلحة على الرغم من تلك الاتفاقيات. ففي سنة 1980 كانت الولايات المتحدة تعدّ الاتحاد السوڤييتي البلد الوحيد الذي يخرق اتفاقية السلاح البيولوجي لعام 1972، وهي الاتفاقية التي تمنع تطوير وتملُّك أسلحة بيولوجية.
وقد ازداد هذا العدد منذئذ على نحو واضح. وجاء في تقرير وضعه عام 1989<W. وبستر> مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن هناك عشر دول على الأقل تطور أسلحة بيولوجية. وذكرت مصادر سماها مكتب التقييم التقاني في جلسات لجان مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1995، أن هناك سبع عشرة دولة تهتم بتطوير السلاح البيولوجي، وذكرت تلك المصادر أن هذه الدول هي إيران والعراق وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية وتايوان وإسرائيل ومصر وڤيتنام ولاوس وكوبا وبلغاريا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والصين وروسيا. (يؤكد القادة الروس أنهم أنْهوا برنامجهم البيولوجي، لكن المسؤولين في الولايات المتحدة يبدون شكوكهم حيال ذلك.)
الحقيقة المروِّعة
إن اهتمام بعض الدول آنفة الذكر في تطوير سلاح بيولوجي أمر يدعو إلى القلق بسبب وضع هذه الدول في إطار الصراعات السائدة. فقد اعترف العراق بما ادّعاه مفتشو الأمم المتحدة من أنه اقتنى في سنة 1991، خلال حرب الخليج، صواريخ سكود Scud مزودة برؤوس حربية بيولوجية. كما ذكر تقرير رفعه البنتاگون إلى الكونگرس عام 1994 أن عدم الاستقرار في دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، قد يشجع دولا أخرى على تطوير أسلحتها البيولوجية والكيميائية.
وعلى المجتمع الدولي أن يبذل جل اهتمامه وجهوده لإيقاف هذا التوجه، لأن التخلص من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية يُعد هدفا جديرا بالاهتمام على الرغم من صعوبته؛ كما أن الفشل في بذل هذه الجهود قد يزيد من احتمال تطوير جرثوم طاعون يصطنعه الإنسان من الإيبولا، أو غيره من المركبات الرهيبة القاتلة.
وهناك حقيقة مروعة أخرى تدفع نحو تدعيم وتعزيز وجوب تكريس الجهود على نحو خاص، نحو نزع السلاح البيولوجي، حيث يشير العديد من السيناريوهات إلى عدم إمكانية حماية الكثير من السكان من هجوم بيولوجي. فاللقاحات قد تحمي من بعض الأمراض، لكن مثل هذا الإجراء الوقائي يبقى عديم الجدوى ما لم يتم مسبقا تعرّف العامل المسبب، لأن فعالية المضادات الحيوية تقتصر على بعض أنواع الجراثيم أو بعض أصناف العوامل البيولوجية وليس عليها كلها. إضافة إلى ذلك فإن إمكانية انتشار مرض معد في العالم ازدادت بوجود سلالات جديدة مقاومة من الجراثيم تستعصي على كل علاج. ففي عصر التقانة الحيوية الذي نعيشه يمكن هندسة جراثيم جديدة تكون اللقاحات والمضادات عديمة الجدوى تجاهها.
كما أن العوائق الفيزيائية لا تستطيع تقديم عون كبير ضد العدوى؛ لكن لحسن الحظ، فإن معظم العوامل البيولوجية لا تستطيع التأثير في الجلد السليم أو من خلاله، كذلك يمكن لأقنعة التنفس والملابس أن تؤمِّن حماية ملائمة لمعظم الناس. كما يمكن لهذا الخطر أن يتراجع بعد فترة قصيرة بسبب فساد هذه العوامل بأشعة الشمس وبحرارة الجو. لكن بعض المتعضيات المجهرية يمكن أن تبقى في جو ما إلى أمد غير محدود. فقد بقيت جزيرة گرينارد على شواطئ اسكتلندا مصابة بأنواع من الجمرة الخبيثة لنحو أربعين سنة بعد إجراء تجارب على الحرب البيولوجية فيها في الأربعينات من هذا القرن. كما يؤكد <R. واطسون> في سنة 1981، حيث كان يشغل منصب مدير مؤسسة الدفاع الكيميائي والبيولوجي، أنه لو ألقيت على برلين خلال الحرب العالمية الثانية قنابل تحمل جراثيم الجمرة الخبيثة، لبقيت هذه المدينة ملوثة حتى يومنا هذا.
وعلى الرغم من تعوّد العديد من الإسرائيليين على ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات خلال حرب الخليج عام 1991، فإنه من غير المنطقي أن نتوقع من غالبية السكان المدنيين ارتداء مثل هذه الأقنعة لأشهر أو لسنوات وبخاصة في المناطق الحارة. وقد ذكر مفتشو الأمم المتحدة في العراق أنهم نادرا ما استطاعوا تحمّل ارتداء هذه الأقنعة لأكثر من خمس عشرة دقيقة في المرة الواحدة.
وقد اشتدت الدعوة، وبخاصة بعد حرب الخليج، إلى ضرورة وضع برامج دفاعية بيولوجية قوية. وتركزت الاقتراحات المقدمة لزيادة ميزانية بحوث الدفاع البيولوجي على حقيقة أن اللقاح وسواه من الإجراءات المتخذة يمكن أن تفيد المدنيين والعسكريين على حد سواء. ولكن حقيقة أخرى تصح على هؤلاء وأولئك أيضا، هي أنه ما لم يكن الهجوم بالسلاح البيولوجي معروفا على نحو مسبق، وما لم يكن هذا السلاح (الجرثوم) سريع التأثر بالمداخلات الطبية المتخذة، فإن كل حديث عن دفاع بيولوجي يبقى مجرد وهم.
وفي واقع الأمر جاءت تجربة حرب الخليج مضلّلة على نحو ما، حيث كان يظن أن الأسلحة البيولوجية العراقية هي عصيّات الجمرة والذيفان الوشيقي (تعدّ الذيفانات، وهي نواتج غير حية تفرزها الكائنات الدقيقة، عوامل بيولوجية وفقا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972)، وكلاهما سريع التأثر باللقاحات والعلاجات المألوفة؛ لذا تبدو وقاية القوات المسلحة من تأثير هذين العاملين أمرا ممكنا، كما أن البحوث التي تقود إلى تعزيز القدرات الدفاعية ضدهما مضمونة بوجه عام.
غير أن عدم إمكانية حماية القوات من عواقب هجوم بعوامل بيولوجية أو كيميائية غير تقليدية أمر يستحق كل عناية واهتمام. ويجب عدم التسرع والقول بإمكانية الوصول بالبحوث التي تقود إلى تعزيز وسائل الدفاع ضد الهجوم بعوامل بيولوجية غير معروفة إلى نتائج أكيدة ومضمونة، لأن ذلك أمر لايزال بعيد المنال. وعدا عن الصعوبات التقنية التي ترافقه، فإن كلفة إقامة نظام دفاع وطني مدني ضد الأسلحة البيولوجية والكيميائية يمكن أن تكون كبيرة جدا. فقد جاء في تقرير نشرته الأمم المتحدة عام 1969 أن نفقات تأمين مخزون احتياطي من الأقنعة الغازية ومن المضادات الحيوية واللقاحات وسواها من إجراءات الدفاع لحماية المدنيين، يمكن أن تزيد على 20 بليون دولار، تصبح في يومنا هذا إذا ما أعيد حسابها مع الأخذ في الاعتبار التضخم الحاصل بالأسعار، قريبة من 80 بليون دولار.
لا يمكن اعتبار اللقاحات أو تجهيزات الوقاية الأخرى، التحديات الوحيدة التي تواجه الدفاع البيولوجي؛ فإمكانية التعرف بسرعة وفي جو المعركة على العامل البيولوجي المستخدم في شن هجوم بالأسلحة البيولوجية هو أيضا أمر لايزال يكتنفه الشك. كما أن تحديد ما إذا كان قد جرى شن هجوم بيولوجي هو أمر يمكن أن يكون موضع شك. ولهذه الاعتبارات أخذ البنتاگون يركز اهتمامات أكبر على وسائل الكشف في هذا المضمار.
العوامل البيولوجية المحتملة
|
ففي الشهر 5/1994 قدّم نائب سكرتير الدولة لشؤون الدفاع الجوي <J. دويتش> تقريرا حول النشاطات المضادة لتكاثر أسلحة الدمار الشامل، جاء فيه أن موضوع وسائل الكشف عن العوامل البيولوجية، بشكل خاص، لا يُتابع على نحو ملائم وكاف، وأوصى بإضافة مبلغ 75 مليون دولار إلى الميزانية السنوية المخصصة لتطوير وسائل الكشف عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية البالغة 110 ملايين دولار. وقد تم بالفعل الشروع في برامج يمولها البنتاگون وتتضمن تطوير تقانات مثل مطيافية الكتلة ذات الفخ الأيوني ion-trap mass spectrometry، والتحليل الطيفي المحرَّض بالليزر، وهي تقانات تعتمد على تحديد البصمة الكيميائية chemical signature للعوامل الخطرة في الجو. ويأمل الجيش الأمريكي في إيجاد مكشاف (كاشف) «نوعي» generic detector يستطيع تعرّف أصناف من العوامل الممرضة، مع إقرار الناطق باسم هذا الجيش بأن هذا الأمل لايزال حلما بعيد المنال.
وفي أثناء ذلك يوجه العسكريون اهتمامهم نحو تقانة أكثر تحديدا وأضيق مجالا تستطيع تعرّف عوامل محددة من خلال تفاعل يجمع بين الجسم المضاد ومولد الضد، وتعرف باسم نظام الكشف البيولوجي المتكامل (BIDS)، حيث يتم تعريض عينات من الهواء المشبوه إلى أجسام مضادة تتفاعل مع عامل بيولوجي محدد؛ ويعني حدوث تفاعل مع هذا الجسم المضاد وجود العامل البيولوجي المحدد، ويستغرق إجراء هذا الكشف نحو 30 دقيقة.
وبهذا النظام يمكن الآن تعرّف أربعة عوامل بيولوجية، وهي عصيّة الجمرة (بكتيرة (جرثومة) الجمرة) anthrax bacterium والطاعون الدبلي bubonic plagueوالذيفان الوشيقي botulinum toxin (وهو السم الذي تطلقه متعضيات التسمم الوشيقي) والذيفان المعوي B ذي المكورات العنقودية (الذي تطلقه بعض البكتيرات العنقودية). وتجري الآن تحريات وبحوث مختبرية لتعرف عوامل إضافية أخرى من خلال تفاعل الجسم المضاد ومولد الضد. إلا أن كبر عدد المتعضيات والذيفانات التي يمكن أن تكون عوامل حربية فعالة يجعل من غير المؤكد القول بأن كل هذه العوامل أو معظمها يمكن أن يكون قابلا للكشف بالنظامBIDS.
تعد الوقاية أفضل وأنجع وسائل الحماية ضد الحرب البيولوجية والإرهاب البيولوجي؛ لذا يعد تعزيز وتقوية إجراءات الاستخبارات ومراقبة الاتجار بالعوامل الممرضة أمرا بالغ الأهمية. وقد تم دعم هذين التوجهين بتدابير احتياطية تضمَّنها مشروع ضد الإرهاب سُنَّ في وقت مبكر من عام 1996. وفي الوقت ذاته صارت محاولات تعرّف الأمراض الطارئة ومراقبتها تتطلب المزيد من الاهتمام والعناية، وكان أحد مظاهر هذا الاهتمام وضع برنامج لمراقبة الأمراض الطارئة يعرف باسم ProMED، اقترحه في سنة 1993 اتحاد العلميين الأمريكيين الذي يضم 3000 عضو.

تجري دراسة العوامل الجرثومية المحتملة وأساليب الدفاع ضدها في مختبر عالي السرية بمعهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي في ولاية ميريلاند. |
وعلى الرغم من أن مؤيدي هذا البرنامج يهتمون عموما بانتشار الأمراض بصورة طبيعية، فإنهم يهتمون على نحو خاص بتتبع إمكانية انتشار وباء أو جائحة من صنع الإنسان. ويتضمن نظام المراقبة المعتمد في هذا البرنامج تطوير قاعدة بيانات عن الأمراض المستوطنة في العالم، والإعلام السريع عن أي انتشار غير طبيعي أو غير مألوف، وكذلك الإجراءات الواجب اعتمادها لكبح جماح المرض، مثل تقديم المشورة والنصيحة عن الاتجار والنقل. ويؤمل بأن يكون هذا البرنامج أكثر قدرة وأشد فعالية مما هو ممكن حاليا، على تحديد الوباء أو الجائحة التي تسببها جهات معادية.
إضافة إلى ذلك، يجب تشجيع ومؤازرة الخطوات الهادفة إلى دعم وتقوية اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، من خلال وضع ترتيبات وإجراءات التحقق التي تتضمن إمكانية تفتيش المواقع. ويتوقع أن تناقش الدول الـ 139 التي تبنت هذه الاتفاقية، إدخال إجراءات التحقق في مؤتمر يعقد لإعادة النظر بالاتفاقية. وكان قد تم في سنة 1991، تشكيل لجنة لتقصي إمكانية اعتماد مثل هذه الإجراءات أطلق عليها اسم ڤيريكس VEREX. وعرضت اللجنة في تقرير لها إمكانيات مختلفة لذلك تتراوح ما بين مراقبة النشرات العلمية إلى إجراءات التفتيش في مواقع الإنتاج، مثل المختبرات ومعامل البيرة والشركات الصيدلانية.
غير أن سهولة إنتاج السلاح البيولوجي ستتيح، لمن يرغب، مخالفة أحكام الاتفاقات الدولية. لكن عدم وجود هذه العوامل البيولوجية الممرضة في الترسانات الوطنية سيحد من هذه المخالفات، كما أن اعتماد تنظيمات مشددة تحد من تملك ونقل هذه العوامل سيجعل من الصعب الحصول عليها لأغراض عدوانية. إلا أن التحقق لن يكون سهلا أبدا، لذا يرى بعض النقاد أن جهود وإجراءات التحقق لن تكون إلا ضياعا للوقت. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مؤيدو هذه الجهود والإجراءات أن العقوبات التي تلي كشف المخالفات ستكون على نحو ما على الأقل عائقا أمام الغشاشين والمخادعين، وهي لذلك أفضل من عدم اتخاذ أي إجراءات على الإطلاق. كما أن اتفاقية دولية شاملة وقوية يمكن أن تدعم تعهد دول العالم بعدم الاتجار بهذه الأسلحة.
لم يستخدم السلاح البيولوجي حتى يومنا هذا إلا نادرا. وهناك أكثر من سبب أو تفسير محتمل لذلك، فمثلا يمكن أن تكون كيفية تطوير العامل الممرض، مازالت خفية على مستخدميه المحتملين؛ وقد يكون هؤلاء تهيّبوا من أن تلحق بهم الإصابة به؛ كما أن استخدام هذه العوامل يعد بحد ذاته منفرا للدول وللجماعات الإرهابية على حد سواء، إذ لا يمكن التنبؤ بآثارها ونتائجها بسبب طبيعتها الخاصة. ففوعة virulence وسُمِّية الجرثوم أو الڤيروس، قد تتغير مع الزمن من خلال التبدلات والطفرات التي تلحق به. فقد تزداد، وقد تنقص مما قد يتعارض ورغبة مستخدميه. وسيشكل هذا العامل الممرض إذا ما حمل إلى وسط ما، تهديدا لكل من في هذا الوسط، مما يستحيل معه احتلال الأرض التي ألقي فوقها أو السيطرة عليها.
ووراء كل هذه الاعتبارات العملية يأتي عامل آخر لم يلق حتى الآن ما يستحقه من اهتمام، وهو النفور الأخلاقي من هذه الأسلحة التي لا قيد عليها ولا حد لقدرتها على التسبب بالمآسي والآلام والمعاناة، وهو أمر أسهم دون أدنى شك في خلق شعور عميق الجذور بمقتها والاشمئزاز منها، يحس به معظم الناس تجاهها. ويبدو هذا المقت أساسيا في بيان سبب عدم استخدام السلاح البيولوجي في الماضي إلا نادرا. لذا وبخلاف التحليلات التي غالبا ما تتجاهل ظاهرة الكراهية هذه أو تستخف بها، فإنه يجب إبرازها وتأكيدها وإشعار مستخدمي هذا السلاح بأن ذلك سينفر الرأي العام العالمي منهم ويبعده عن قضيتهم.
السم المحرّم
وانطلاقا من هذه المشاعر والأحاسيس تصف اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 السلاح البكتيري (الجرثومي) بأنه «مقيت ومنفّر للضمير البشري». وترجع جذور هذا الوصف آلاف السنين إلى الوراء، (إذ لم يعرف حتى القرن التاسع عشر أن الكائنات المجهرية هي سبب المرض والإصابة به. وكان ينظر إلى السم والمرض قبل ذلك على أنهما شيء واحد، حتى إن الكلمة اللاتينية الدالة على «السم» هي «ڤيروس»).
كان تسميم الطعام ومياه الشرب واستخدام الأسلحة السامة، يعدان من المحرمات في العديد من الحضارات القديمة. وقد أدان اليونانيون والرومانيون استخدام السم في الحروب وعدّوه انتهاكا لقانون الأمم Law of nations. كما مُنعت السموم وغيرها من الأسلحة غير الإنسانية في قانون مانو Manu في الهند نحو عام 500 ق.م، وعند العرب المسلمين بعد ذلك بنحو 10000 سنة. وتكرر هذا المنع من قبل رجل الدولة الألماني <H. گروتيوس> في عمله المهم عام 1625 قانون الحرب والسلم The Law of War and Peace. وظل هذا المنع قائما معظم الوقت خلال الحروب والصراعات الدينية المؤلمة التي شهدتها أوروبا في ذلك الحين.
إن انتهاك الحرمات وأكل لحوم البشر وغير ذلك من الأعمال الملعونة والمقززة، تعد من المحرمات؛ إلا أنها كانت تنتهك أحيانا. وبمثل ذلك كان حظر استخدام سلاح السموم ينتهك أحيانا، إلا أن ذلك كان نادر الوقوع لأن منتهكه كان يعاقب «لخرقه المبادئ القويمة»، كما جاء في كلمات القاضي الإنكليزي <P .R. وارد> في القرنين الثامن والتاسع عشر، حيث يقول «ليس هناك ما هو أكثر تحريما من استخدام الأسلحة المسمومة» (وقد جاء التأكيد على كلمة المسمومة في الأصل).
وجاء المؤرخ <E .J. مون>، وهو الآن أستاذ فخري في ماساتشوستس يؤكد أن نمو الشعور القومي في القرن التاسع عشر، أضعف الإحساس بالنفور من الأسلحة السامة. ونتيجة لما دعاه مون «تأميم علم الأخلاق»، بدأت الضرورات الحربية تنحِّي جانبا الاعتبارات الأخلاقية في سياسات الدول، وأصبحت هذه الأخيرة تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لإدراك غايتها في الحرب.
الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية
| الكمامة أو القناع الغازي تحجز المرشحات المصنوعة عادة من الفحم الفعال، الجسيمات الأكبر من 1 ميكرون. ويُنصح بلبس رداء واق خارجي لحماية الجروح المفتوحة أو الجلد المخدوش من التعرض للتماس بالعوامل البيولوجية.
ملجأ الحماية وأفضله ما كان في غرفة مغلقة معزولة بصورة تامة، باستخدام البلاستيك وسواه من المواد غير النفوذة، ومهواة بهواء نقي مصفّى. التطهير يعد استخدام المطهرات أو مبيدات الجراثيم مثل ألدهيد النمل (فورم ألدهيد)، فعالا لتعقيم السطوح. التلقيح ويكون ضد عامل بيولوجي محدّد أو نوعي. وتتطلب بعض هذه العوامل تكرار التلقيح أكثر من مرة وخلال فترة مديدة حتى تتحقق المناعة. ولا تتوافر اللقاحات المناسبة للعديد من العوامل البيولوجية. المضادات الحيوية وهي فعالة ضد بعض الجراثيم وليس ضدها كلها، (وغير فعالة تجاه الڤيروسات). يجب أن تبدأ المعالجة بالمضاد الحيوي عند التعرض لبعض الجراثيم، خلال بضع ساعات من التعرض وقبل بدء الأعراض بالظهور. أنظمة الكشف تتوافر بعض الوحدات الميدانية البدائية التي تكشف عددا ضئيلا من العوامل البيولوجية. وتُجرى بحوث لزيادة عدد هذه العوامل التي يمكن كشفها في ظروف المعارك الحربية وفي غيرها. |
وقد اقترح بعض القادة العسكريين، في منتصف القرن التاسع عشر، استخدام الأسلحة السامة، ولكن ذلك لم يتم. وجاءت الحرب العالمية الأولى واستخدمت فيها الغازات، وكانت تجربة الحرب الكيميائية هذه مرعبة لدرجة قادت معها إلى وضع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام العوامل الكيميائية والبيولوجية في الحرب؛ وكان لصور ضحاياها وهم يلهثون ويزبدون ويموتون اختناقا، تأثير عميق. وتعكس عبارات البروتوكول الشعور العام بالمقت والكراهية تجاه هذه العوامل حيث يؤكد «أن الرأي العام في العالم المتمدن قد أدان هذه الأسلحة».
لم تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد ذلك على الإطلاق في مئات الحروب والمناوشات التي جرت في العقود اللاحقة، حتى جاء الهجوم العراقي الكيميائي الواسع النطاق خلال الحرب العراقية الإيرانية. وكان مما يدعو للأسف أن جاء الرد الدولي على هذا السلوك العراقي صامتا خجولا لا يحمل أي إدانة؛ وهكذا سُمح للعراق منذ عام 1983 وحتى نهاية الحرب في 1988 أن ينجو بنفسه وينصرف بسلاحه الكيميائي القاتل. لقد أخمد الخوف من انتصار إيراني صوت كل احتجاج جدي ضد أحد أشكال التسلح التي أدانها العالم بأسره.
لم تكن نتائج هذا الصمت، الذي ليس له ما يبرره، حيال السلوك العراقي مفاجئة. فقد غدا العراق بمقدرته على استخدام الأسلحة الكيميائية من دون تعرضه لأي ردع أو عقاب، وغدت هذه الأسلحة بفعاليتها الظاهرة ضد إيران، مثالا ما لبثت أن حذت حذوه دول أخرى حرصت على التزود بدورها بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ومما يدعو إلى السخرية أن نرى العديد من الدول التي لاذت بالصمت حين الهجوم الكيميائي العراقي، صار لزامًا عليها أن تواجه بدورها عراقا مزودا بأسلحة كيميائية وبيولوجية في أرض المعركة التي انطلقت في سنة 1991.
ومنذ حرب الخليج هذه، أخذ المجتمع الدولي يضغط على العراق لكشف برامج تسليحه غير التقليدي من خلال الإبقاء على العقوبات المفروضة عليه من مجلس الأمن. وقد تضمنت قرارات هذا المجلس القضاء على الأسلحة البيولوجية العراقية (وسواها من أسلحة الدمار الشامل)، كما تضمنت الحصول على معلومات عن برامجه السابقة لتطويرها، حيث كان العراق على وشك الوصول جزئيا إلى غاياته فيها. ولايزال مفتشو الأمم المتحدة يواصلون بحثهم وتقصيهم.
لكن تقارير الأمم المتحدة لاتزال حتى الآن وبصورة عامة تقارير جافة تخلو، إلا فيما ندر، من عبارات الإدانة والاستنكار؛ وهذا الاستنكار وتلك الإدانة هما ما يجب أن يوجه لأي دولة أو مجموعة تعمل على تطوير هذه الأسلحة. كما أننا نحتاج إلى من يذكرنا دوما وباستمرار أن الشعوب المتمدنة لا تتاجر بمثل هذه الأسلحة ولا تستخدمها. ويجب أن تساعد على ذلك الاتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا لتدمير مخزونهما من الأسلحة الكيميائية خلال عقد من الزمن.
إلا أنه من الواضح أن عبارات الاستنكار والإدانة لا تكفي وحدها؛ ودور أجهزة الاستخبارات مهم في هذا المجال؛ ويجب أن يخضع نقل العوامل الممرضة داخل البلاد وخارجها إلى رقابة صارمة؛ كما يجب دعم وتعزيز المراقبة العامة والشاملة لانتشار الأمراض والأوبئة. إضافة إلى ذلك فإن قيام المؤسسات التي تدعم وتعزز القيم والسلوك الإيجابي يعد أمرا أساسيا.
ويأتي حاليًا في مقدمة الأولويات في هذا المجال، تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (Ch.W.C) التي تحرّم تملك هذا السلاح، وتحدد المواد الكيميائية التي يتوجب على الدول التي وقعت الاتفاقية أن تصرح بامتلاكها لها. وفي المعاهدة الكيميائية، بخلاف اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تدابير احتياطية شاملة للتحقق من الإذعان لأحكامها، بما في ذلك التحري القريب، أي التحري بعد إنذار قصير الأمد عن الانتهاكات المشكوك فيها. كما أن فيها دوافع إضافية تحض على الانضمام إليها وذلك من خلال تبادل المعلومات والامتيازات التجارية التي تقوم بين الموقّعين.
تم إعداد المعاهدة الكيميائية للتوقيع في سنة 1993، وحتى الشهر 10/1996 تم توقيعها من قبل 160 دولة، كما تم اعتمادها والتصديق عليها من قبل 64 دولة، وهو أقل بصوت واحد من العدد اللازم لدخولها حيز التنفيذ. وكان إحجام الولايات المتحدة عن ذلك مخيبا للآمال، وجاء بسبب الخلاف القائم حول إجراءات التحقق من المعاهدة؛ وقد أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا التصويت عليها.
وسيؤدي اعتماد معاهدة الأسلحة الكيميائية إلى إعطاء زخم ودفع للمحادثات الجارية لدعم وتقوية اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أن فشل تلك المعاهدة في الاستجابة للتطلعات المعقودة عليها، سيثبط بالمقابل، احتمال قيام نظام تحقق للاتفاقية البيولوجية، وستكون النتيجة الأكثر احتمالا لذلك هي متابعة إنتاج وتخزين الترسانات الكيميائية والبيولوجية حول العالم، علما بأنه كلما طال أمد بقاء هذه الأسلحة قيد التداول ضعف الحس بعدم شرعيتها وازداد احتمال استخدامها من قبل القوات المسلحة أو من قبل مجموعات إرهابية.
وقد ذكر المحللون أن بوسع بعض التنظيمات الفرعية أحيانا أن تستخدم الأسلحة التي في ترساناتها الوطنية؛ لذلك فإن عدم توافر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في تلك الترسانات قد يضعف من رغبة مجموعات إرهابية في استخدامها. وتبعا لما ذكره <M .B. جنكينز> ، الخبير في شؤون الإرهاب، فإن قادة «مجموعة الحقيقة الأسمى» اليابانيين ذكروا أنهم استوحوا اهتمامهم بالسلاح الكيميائي من خلال استخدامه من قبل العراق في حربه مع إيران.
تشكل المعاهدات وأنظمة التحقق والإشراف الشامل ومراقبة الاتجار بالعوامل الممرضة، القوة الفاعلة في شأن مراقبة التسلح. وتتوقف فعالية هذه القوة في المرحلة الأخيرة على الإرادة الحقيقية التي تدعمها وتؤازرها وعلى مدى الرغبة في هذا الدعم القوي الصارم. إن التأكيد على الحس الأخلاقي مع إجراءات الحظر الرسمية للأسلحة البيولوجية يدعم منع استخدام هذه الأسلحة ويجعله أكثر احتمالا.
المؤلف
Leonard A. Cole
أستاذ للعلوم السياسية، ويشارك في برنامج عن العلم والتقانة والمجتمع، في جامعة روتجرز بولاية نيوجرسي. ويعتبر كول مرجعا في مجال العلم والسياسة العامة، وله خبرة كبيرة في رسم السياسات الخاصة بالحرب الكيميائية والبيولوجية وسواها من القضايا الصحية. حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا عام 1961، وعلى الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا عام 1970.
مراجع للاستزادة
CLOUDS OF SECRECY: THE ARMY’S GERM WARFARE TESTS OVER POPULATED AREAS. Leonard A. Cole. Rowman and Littlefield, 1990.
BIOLOGICAL WEAPONS: WEAPONS OF THE FUTURE? Edited by Brad Robens. Center for Strategic and International Studies, 1993.
BIOLOGICAL WARFARE IN THE 21ST CENTURY. Malcolm Dando. Macmillan, 1994.
THE ELEVENTH PLAGUE: THE POLITICS OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL WARFARE. Leonard A. Cole. W H. Freeman and Company, 1996.
Scientific American, December 1996