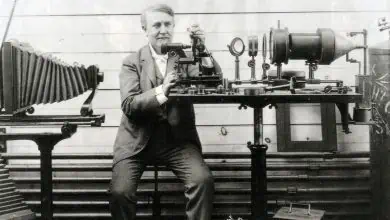النمو الأخلاقي للأولاد
النمو الأخلاقي للأولاد
لا يكفي أن يميز الأولاد بين الخطأ والصواب، بل يتعين
أن ينمو لديهم الالتزام بالتصرف وفقا لمُثُلهم.
<W. دامون>
تُحدثنا التقارير الإخبارية، بين الحين والآخر، عن أولاد يُلحقون الدمار بمدارسهم ومجتمعاتهم المحلية: يهاجمون مدرسيهم ورفاق صفهم، أو يقتلون آباءَهم، أو يضايقون الآخرين، وذلك نتيجة لفساد أخلاقهم أو للسطو أو لمجرد النكاية والحقد. ونسمع عن عصابات ضارية من الأولاد تُهرب المخدرات، وجرائم اغتصاب يرتكبها صبية مراهقون، وتخريب متعمَّد يقوم به صبية صغار، وعن تفشي الغش حتى في مدارس المتفوقين. وقبل وقت ليس بالبعيد قامت عصابة من اليافعين من أبناء الطبقة الوسطى بترويع إحدى الضواحي الغنية بكاليفورنيا من خلال عمليات ابتزاز وتهديد بالقتل، مسجلين لأنفسهم باعتزاز نقاطا مع كل حالة تعدٍّ على قاطني هذه الضاحية. ومثل تلك القصص التي نسمع ونقرأ عنها تجعل من «إله الذباب»(1) عملا نبوئيا على نحو مخيف.
وفي مواجهة مثل هذه الأخبار المخيفة ينسى الكثيرون منا حقيقة أن أغلب الأولاد يتبعون في معظم الحالات قواعد مجتمعاتهم، فيتصرفون على نحو لائق، ويعاملون الأصدقاء بتعاطف، ويقولون الحقيقة ويحترمون الوالدين. بل إن كثيرا من اليافعين يفعلون أكثر من ذلك. فقسم كبير من الشبان الأمريكيين يتطوع في الخدمة المجتمعية (طبقا لإحدى الدراسات المسحية يتطوع ما بين 22 و 24 في المئة تبعا للموقع). كذلك يتبوأ يافعون أدوارا قيادية في القضايا الاجتماعية. وقد كتب <R. كولز> [أستاذ الطب النفسي بجامعة هارڤارد] عن أولاد مثل <روبي>، وهي فتاة أمريكية من أصول إفريقية نجحت في كسر حاجز «اللون» في مدرستها خلال الستينات. وأثبت سلوكها اليومي داخل مدرسة جميع طلبتها من البيض، أن لديها حسا أخلاقيا شجاعا. وكانت روبي، عندما تتعرض لإهانات أو سخريات زملائها، تصلي من أجل خلاصهم بدلا من لعنهم. ويذكر كولز أن روبي كانت «تمتلك إرادة قوية وظفتها لخيارات أخلاقية؛ لقد برهنت على جَلَدٍ أخلاقي لا يلين، وامتلكت النقاء والشجاعة.»
إن جميع الأطفال يولدون معدّين للسير على طريق النمو الأخلاقي. ويهيئ عدد من الاستجابات الفطرية هؤلاء الأطفال الصغار للتصرف تصرفات أخلاقية. فعلى سبيل المثال، التقمص الوجداني أو العاطفي ـ أي قدرة الفرد على معايشة فرحة شخص آخر أو حزنه كأنها فرحته أو حزنه ـ يمثل جزءا من طبيعتنا كبشر. فالأطفال المولودون حديثا يعلو صراخهم حين يسمعون الآخرين يصرخون وتبدو عليهم علامات الفرح عند سماعهم أصواتا سعيدة كالضحك أو عبارات الترحيب. وفي عامهم الثاني، فإن الأطفال عادة ما يواسون أقرانهم أو والديهم عندما يكون هؤلاء مكروبين.
وفي بعض الأحيان لا يعرف هؤلاء الصغار تماما ما يمكنهم تقديمه من عون. يروي <L .M. هوفمان> [أستاذ علم النفس في جامعة نيويورك] أنه شاهد ذات يوم طفلا لم يتعلم المشي بعد يقدم لأمه البطانية التي تحميه من البرد عندما أحس أنها محبطة. غير أنه على الرغم من وجود النزعة العاطفية إلى المساعدة، فإن الوسائل التي يمكن بها مساعدة الآخرين بفاعلية ينبغي تعلمها وصقلها من خلال التجربة الاجتماعية. وفضلا عن ذلك فإن طاقة المشاركة الوجدانية تخفت، بل تتلاشى عند العديد من الناس، كما أنهم يمكن أن يتصرفوا بقسوة إزاء مَن يرفضون التعاطف معهم. سأل رجل شرطة من نيويورك ذات مرة مراهقا ارتكب العديد من جرائم القتل، من أين جاءته القدرة على أن يطلق النار على امرأة في الثالثة والثمانين من عمرها خلال سطو مسلح، فأجابه الصبي: «ما الذي يعنيني؟ أنا لست هي.»
إن توصيفا علميا للنمو الأخلاقي يتعين أن يقدم تفسيرا لكل من الطيِّب والسيئ. فلماذا يتصرف أغلب الأطفال بطرق أخلاقية مقبولة ـ وأحيانا على نحو غير معهود ـ حتى عندما يتهدد الأمر مصالحهم الشخصية المباشرة؟ ولماذا يشذ بعض الأطفال عن المعايير المقبولة، وعلى نحو يلحق الضرر في أحيان كثيرة بهم أنفسهم وبالآخرين؟ كيف يكتسب الطفل عادات وأعرافا مجتمعية وينمو لديه التزام على امتداد حياته بالسلوك الأخلاقي، أو لا؟

عبر مواقف مثل تهدئة روع طفل خائف، أو المساهمة في الخدمة العامة، أو التصارع على شيء ما، يعيش الأطفال منذ سن مبكرة جدا حياة أخلاقية أكثر غنى مما يفترضه البالغون. والمشكلة الأهم بالنسبة إلى العلماء هي إجراء عمليات تبسيط بما يكفي لقول شيء مفيد بشأن سلوك الأطفال من دون أن يصل هذا التبسيط إلى حد يفقدهم الإحساس بالتعقيد النفسي (السيكولوجي). |
لا يملك علماء النفس إجابات محددة لهذه الأسئلة، وكثيرا ما تبدو دراساتهم مجرد تأكيدات لملاحظات الوالدين وحدسهم. غير أن الوالدين، شأنهم في ذلك شأن سائر الناس، يمكن أن تضللهم التحيزات الشخصية، والمعلومات الناقصة، والنزعة الإثارية لوسائل الإعلام. فقد يلقون باللائمة على حادث تافه نسبيا ـ حفل موسيقي، مثلا ـ في مواجهة مشكلة عميقة الجذور مثل إدمان المخدرات. وربما أرجعوا مشكلاتهم الشخصية، خطأ، إلى تنشئة صارمة، ومن ثم يحاولون التعويض بتربية أطفالهم بطريقة مفرطة في التساهل. وفي موضوع هو محل لخلافات محتدمة، مثل «القيم الأخلاقية للأطفال،» فإن النهج العلمي هو السبيل الوحيد لتفادي التأرجحات الجامحة لرد الفعل العاطفي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تكرار الأخطاء نفسها.
أصول السلوك الأخلاقي
لقد أصبحت دراسة النمو الأخلاقي ميدانا لنشاط بحثي متنامٍ في حقل العلوم الاجتماعية. وتحفل الدوريات العلمية بالنتائج البحثية الجديدة والنماذج المتنافسة. وفي حين تركز بعض النظريات على القوى البيولوجية الطبيعية، تؤكد نظريات أخرى على كل من التأثير والتجربة الاجتماعيين، كما أن هناك نظريات أخرى تركز على ملكة التمييز الناشئة عن التطور العقلي للأطفال. ومع أن كل نمط من هذه النظريات يركز على شيء مختف، فإنها تسلم جميعا بأنه لا يمكن لسبب واحد أن يفسر السلوك الأخلاقي أو اللاأخلاقي. فمشاهدة أفلام فيديو تزخر بمشاهد العنف، أو ممارسة ألعاب إطلاق النار الحاسوبية قد تجعل بعض الأطفال سريعي الاستثارة، في حين لا تترك تأثيرا لدى أطفال آخرين. إن الفهم العادي يركز كل اهتمامه في الوجه الظاهر وحده، بيد أن الفهم العلمي لا بد أن يُبنى على إدراك تعقد وتنوع حياة الأطفال.
المراحل الست للحكم الأخلاقي
| مع اطراد نموهم، يبدأ الأولاد والشباب بالاعتماد بدرجة أقل على الانضباط «الخارجي» وبدرجة أكبر على المعتقدات التي ترسخت في نفوسهم؛ وهم يمرون في ذلك بست مراحل (جُمّعت في ثلاثة مستويات) للتفكير الأخلاقي، وذلك حسبما ذكر لأول مرة على لسان عالم النفس <L. كولبرگ> في أواخر الخمسينات (انظر أدناه). وقد تضمنت الدلائل المؤيدة لصحة هذا النموذج دراسة طويلة الأمد أجريت على 58 من الشبان الذين عُقدت معهم لقاءات دورية منتظمة على مدى عقدين من الزمن. وكان معيار الحكم على مدى نضجهم الأخلاقي قائما على الكيفية التي حللوا بها مآزق مفترضة؛ كأن يسألون ما إذا كان يصح للزوج أن يسرق مخدرا من أجل زوجته المحتضرة. ولم تكن الإجابة، بنعم أو لا، ذات أهمية هنا، بل كان المهم هو كيف يبرر الشاب هذه الإجابة. ومع اطراد نمو هؤلاء الشبان فإنهم مروا في المراحل الست بالتعاقب، وإن تم ذلك بمعدلات متفاوتة (انظر الرسم البياني). على أن المرحلة السادسة ظلت محيرة. وعلى الرغم من النجاح العام لهذا النموذج فيما يتعلق بالنمو العقلي فإنه لا يفسر السلوك الفعلي للناس.
المستوى الأول: المصلحة الشخصية المرحلة 1 العقاب: «لا أريد أن أفعل هذا، لأنني لا أريد أن أعاقب.» المرحلة 2 الثواب: «لا أريد أن أفعل هذا، لأنني أريد أن أكافأ.» المستوى الثاني : القبول الاجتماعي المرحلة 3 العلاقات بين الأشخاص: «لا أريد أن أفعل هذا، لأنني أريد أن يحبني الناس.» المرحلة 4 النظام الاجتماعي: «لا أريد أن أفعل هذا، لأن ذلك يمكن أن ينتهك القانون.» المستوى الثالث : المثل المجردة المرحلة 5 العقد الاجتماعي: «لا أريد أن أفعل هذا، لأنني ملتزم بألا أفعله.» المرحلة 6 الحق الشامل: «لا أريد أن أفعل هذا، لأنه غير صحيح، أيا كان رأي الآخرين.»
|
تذهب النظريات ذات المنطلق البيولوجي، أو بتعبير آخر نظريات «النزعة الفطرية»، إلى أن الأخلاقية الإنسانية تنبع من ميول فطرية متأصلة لدى نوعنا البشري. وقد أثبت كل من <هوفمان> و<C. تريفارتين> [من جامعة إدنبرگ] و<N. أيزنبرگ> [من جامعة ولاية أريزونا] أن الأطفال الحديثي الولادة يمكن أن يشعروا بالتعاطف ما إن يدركوا وجود الآخرين ـ وأحيانا في الأسبوع الأول بعد الولادة. ومن بين العواطف الأخلاقية التي تتجلى مبكرا الخجل والشعور بالذنب والشعور بالإهانة. كذلك يمكن للأطفال الصغار، على حد قول <S .J. كاجان> [أستاذ علم نفس الطفل]، أن يشعروا بالغضب إزاء انتهاك التوقعات الاجتماعية، كمخالفة القواعد في لعبة محددة أو تثبيت أزرار غريبة على قطعة ثياب معهودة.
إن كل إنسان تقريبا، وفي جميع الثقافات، يرث هذه الميول الفطرية. وقد أثبتت <D .M. إينسورث> [من جامعة فرجينيا] وجود شعور «التعاطف» لدى الأطفال الأوغنديين والأمريكيين، الذين أجرت دراستها عليهم. كذلك أجرت <N. فيشباخ> [من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس] مقارنة مشابهة بين الأطفال الحديثي الولادة في كل من أوروبا وفلسطين والولايات المتحدة. ودرس <C .M. مادسيني> [من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس] «المشاركة» لدى أطفال ما قبل المدرسة في إحدى عشرة ثقافة. وتقول خبرة علماء النفس إن الأطفال في كل مكان يبدؤون حياتهم بمشاعر الاهتمام تجاه القريبين منهم وردود فعل مناوئة للمسلك غير الإنساني أو المتعنت. ولا تظهر الفوارق في مدى استثارة ردود الفعل أو التعبير عنها إلا في وقت لاحق، بعد أن يتشرب الأطفال نظم القيم التي تنطوي عليها ثقافاتهم.
وعلى النقيض من ذلك تركز نظريات «التعلم» على اكتساب الأطفال للمعايير والقيم السلوكية من خلال الملاحظة والتقليد والجزاء. وقد استنتجت الدراسات التي أُجريت في ظل هذا النهج أن السلوك الأخلاقي محكوم بالبيئة المحيطة، وأنه يتفاوت من موقف لآخر، وفي أكثر الأحيان بشكل مستقل عن الاعتقادات المعلنة. ومن بين الدراسات الرائدة التي شهدها عقد العشرينات، والتي يُستشهد بها كثيرا حتى الآن، تلك الدراسة المسحية التي أجراها <H. هارتشون> و<M. ماي> للكيفية التي جاء بها رد فعل الأطفال عندما هُيئت لهم فرصة الغش. فقد اعتمد سلوك الأطفال إلى حد كبير على ما إذا كانوا يعتقدون أن احتمال ضبطهم قائم أو لا، ولم يكن سلوكهم قابلا للتنبؤ على ضوء سلوكهم في مواقف سابقة أو من خلال معرفتهم بالقواعد الأخلاقية العامة، كالوصايا العشر أو تقاليد الكشافة.
وقد اكتشف <R. بيرتون> [من جامعة ولاية نيويورك] من خلال إعادة تحليل بيانات (معطيات) هارتشون وماي في وقت لاحق، اتجاها عاما واحدا على الأقل: فإقدام الأطفال على الغش كان مرجحا أكثر مقارنة بالمراهقين. وقد يكون لعاملي التنشئة الاجتماعية والنمو العقلي دور ما في تحجيم السلوك المفتقر للأمانة، بيد أن مثل هذا التأثير لم يكن كبيرا.
أما النظرية الثالثة في النمو الأخلاقي فتؤكد «النمو العقلي»، ذاهبة إلى القول إن الفضيلة والرذيلة هما في النهاية مسألة اختيار واع. وتُعد نظريتا عالمي النفس <J. بياجيه> و<L. كولبرگ> النظريتين الأكثر شهرة بين مجموعة النظريات الإدراكية. وقد وصفت كل من النظريتين المعتقدات الأخلاقية المبكرة للأطفال الصغار على أنها موجهة نحو القوة والسلطة. فبالنسبة إلى الأولاد، إن الحق هو للقوة في واقع الحال. وبمرور الوقت يبدؤون بإدراك أن القواعد الاجتماعية هي من صنع الناس، ومن ثم فبالإمكان النظر في صلاحيتها، وأن التبادلية في العلاقات هي أعدل من الطاعة من جانب واحد. ويحدد كولبرگ تعاقبا من ست مراحل لنضج الحكم الأخلاقي (انظر الشكل في الصفحة المقابلة). وقد استخدمت بضعة آلاف من الدراسات هذا التقسيم لمراحل النضج مقياسا لمدى تقدم التفكير الأخلاقي لدى الفرد.
الضمير في مواجهة الشيكولاته(2)
مع أن المكونات الأساسية للتعاقب الذي اقترحه كولبرگ تأكدت صحتها، فقد برزت استثناءات عديدة جديرة بالذكر. من ذلك أن نسبة ضئيلة جدا من الناس هي التي تصل إلى المرحلة السادسة الأكثر تقدما، والتي تعتمد فيها الآراء الأخلاقية على مبادئ مجردة. كذلك وجدت دراسات عديدة فيما يتعلق بالمراحل الأولى في التعاقب (بما في ذلك بعض الدراسات الطويلة الأمد) أن الأولاد الصغار يتمتعون بحس أخلاقي إيجابي أغنى مما يشير إليه النموذج؛ أو بعبارة أخرى أن تصرفهم لا يقوم على مجرد الخوف من العقاب. فعندما يأخذ أحد رفاق اللعب أكثر من نصيبه من طبق الكعك أو يرفض ترك الأرجوحة لرفيق آخر، فإن الاحتجاج بأن «هذا ليس عدلا!» يمثل رد الفعل السائد. وفي الوقت ذاته يدرك الأطفال أن من واجبهم مشاركة الآخرين ـ حتى لو طلب الوالدان إليهم ألا يفعلوا ذلك. كذلك يؤمن أطفال ما قبل المدرسة بوجه عام بالتوزيع المتكافئ للأشياء بينهم ويدعمون اعتقادهم هذا بأسباب مثل الرغبة في إسعاد الآخرين («أود أن يشعر صديقي بالسرور»)، والتبادلية («إنها تشركني في اللعب بدميتها»)، والمساواتية («ينبغي أن تكون لدينا جميعا الأشياء نفسها»). كل ذلك يكتشفونه خلال المواجهة مع رفاقهم في اللعب.. كما يتعلمون أنه في غياب العدالة لا بد من وقوع مشكلات.
«هل يمكنك أن تسامح نفسك؟»
| في أحد الأحياء الفقيرة بمدينة «كامدن» بولاية نيوجيرسي، أجرى عالم النفس الاجتماعي <D. هارت> [من جامعة روتجرز] هذا الحوار مع يافع أمريكي إفريقي الأصل من ذوي النشاط البارز في ميدان الخدمة الاجتماعية:
كيف تصف نفسك؟ إنني من ذلك النوع من الأشخاص الراغبين في المشاركة والذين يؤمنون بأهميتها. لقد أصبتُ مؤخرا بهذه العقدة، كما أسميها، حيث ينظر الناس إلى «مدينة كامدن» على أنها مكان سيئ، وهو ما يضايقني كثيرا. فكما تعلم، إن لكل مدينة أماكنها السيئة الخاصة بها. وكل ما أريده هو أن أعمل مع الناس. أعمل من أجل تغيير تلك الصورة الماثلة في الأذهان عن «كامدن». وليس بإمكانك أن تبدأ بالأشخاص البالغين، لأنهم غير قابلين للتغير؛ لكن إذا أمكنك أن تصل إلى عقول الأولاد الصغار، وأن توضح لهم ما هو خطأ وتجعلهم يدركون أنك لا تريد أن يسلكوا ذلك الطريق، فإن ذلك الأسلوب يمكن أن ينجح، لأنهم أكثر قابلية للإقناع. هل هناك حقا حل صحيح واحد للمشكلات الأخلاقية مثل ذلك الذي تطرحه؟ أساسا، الأمر كما قلت أعلاه. إن عليك أن تحاول إنقاذ حياة إنسان. كيف تعرف؟ حسنا الأمر في حقيقته هو كيف يمكنك أن تسامح نفسك؟ لو افترضنا أن بإمكاني أن أساعد شخصا في الحفاظ على حياته، فهل يمكنني أن أتركه يموت؟ أعني أنني لن أستطيع أن أسامح نفسي إذا ما حدث ذلك. قبل سنوات قليلة قُتلت شقيقتي، و… في الليلة التي قُتلت فيها كنت موجودا في منزلها في وقت سابق من ذلك اليوم. فلو أنني أمضيت تلك الليلة بمنزلها، ربما لم يكن ذلك قد حدث. أنت تقول إن تأثيرك في الآخرين ليس سيئا، لماذا ترى ذلك مهما؟ إنني أحاول ألا أكون قدوة سيئة. إن لكل منا صفاته السيئة، بطبيعة الحال. ومع ذلك فإن عليك أن تكون قدوة حتى وأنت مجرد شخص تعبر الشارع. إننا نعيش الآن، كما تعرف، وسط مجتمع فيه المجرمون وفيه اللصوص، وهناك متعاطو المخدرات، والأولاد يتفحصونهم بأنظارهم. فلو أنهم رأوا تاجرا للمخدرات وفي حوزته الكثير من المال، فستحفزهم رغبتهم في الحصول على المال إلى بيع المخدرات. لذلك من المهم أن تحاول ألا يكون تأثيرك سيئا، لأن ذلك يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية بعيدة الأمد. فمثلا، عندما تطلب إلى أختك الصغيرة أو أخيك الصغير أن يلتزما الهدوء لئلا يستيقظ والداك من نومهما فتُجبَر على الذهاب إلى المدرسة، فإنهما سيعتادان على الهدوء عندما لا يرغبان في الذهاب إلى المدرسة… وهكذا فإن للتأثير السيئ مردودا بعيد الأمد. ولماذا لا تريد أن يحدث ذلك؟ لأن هناك في مجتمع اليوم الكثير من الجرائم ومن العنف. أقصد في كل مكان. وقد عانيت شخصيا من ذلك العنف، لأن شقيقتي قُتلت. إن علينا أن نسعى لئلا يحدث أي من هذا في المستقبل. ولذلك نحتاج إلى تعليم أولادنا بطرائق أخرى. |
على أن أيا من النظريات التقليدية الثلاث ـ السالفة الذكر ـ ليست كافية في واقع الأمر لتفسير النمو الأخلاقي للأطفال وسلوكياتهم. ذلك أن أيا من هذه النظريات لم يُعنَ بالبعدين الأكثر أساسية للحياة الأخلاقية، وهما الشخصية والالتزام. فالسؤال الأساسي، بغض النظر عن الكيفية التي يطور بها الأطفال نسق قيمهم الأوّلي، هو: ما الذي يجعلهم يتصرفون في حياتهم وفق مُثُلهم؟ إن هذه القضية هي التي تمثل بؤرة التفكير العلمي الحديث.
إن الأولاد، شأنهم في ذلك شأن البالغين، يقاومون الإغواء. ومن أجل فهم الكيفية التي يتجلى بها هذا الصراع العنيف في عالم الأولاد الصغار، أجريت مع زملائي عندما كنا نعمل وقتها في جامعة كلارك، التجربة التالية: أحضرنا عدة مجموعات من الأولاد تتألف كل مجموعة منها من أربعة، إلى مختبرنا وأعطيناهم خيطا وخرزا، وطلبنا إليهم أن يصنعوا منها أساور وعقودا. ثم شكرناهم بشدة، بعد انتهائهم، على جهدهم الممتاز وكافأناهم، كمجموعة، بعشرة قوالب شيكولاته. بعدئذ بدأت التجربة الفعلية، فقد قلنا لكل مجموعة إن عليها أن تقرر الطريقة المثلى لتوزيع المكافأة. وتركنا الغرفة وأخذنا نراقب الموقف من خلال مرآة أحادية الاتجاه.
قبل التجربة، كنا قد سألنا الأولاد المشاركين عن مفهوم العدل. إذ كنّا تواقين، بالطبع، لاستكشاف ما إذا كانت فكرة التهام شيكولاته حقيقية يمكن أن تعصف بتصورهم المجرد عن العدل والظلم، وعن الصواب والخطأ. ومن أجل اختبار ذلك على نحو مكتمل وشامل، وضعنا مجموعة قياسية من الأولاد أمام مشكلة مماثلة، مستخدمين هذه المرة مستطيلات كرتونية بدلا من الشيكولاته الحقيقية ـ وهي طريقة ليست حاذقة تماما للتخفيف من حدة حرصهم على مصلحتهم الشخصية ـ وأخذنا نراقب عدة فئات من الأولاد من سن أربع وست وثماني وعشر سنوات لنرى ما إذا كانت العلاقة بين الأخلاقية الوضعية(3) والأخلاقية الافتراضية تتغير بتغير العمر.
إلى أي مدى تتسم القيم الأخلاقية بالشمول؟
| إن الأهمية الملموسة للقيم المشتركة فيما يتعلق بالتطور الأخلاقي للأولاد تطرح بعضا من الأسئلة الأكثر إثارة للجدل في حقلي الفلسفة والعلوم الاجتماعية المعاصرين. فهل تختلف القيم الأخلاقية باختلاف المكان، أم أن هناك مجموعة من القيم الأخلاقية الشاملة توجه التطور الأخلاقي في كل مكان؟ وهل يكتسب الأطفال الذين ينشؤون في ثقافات مختلفة أو في أزمنة مختلفة عادات أخلاقية متباينة جوهريا؟
لقد سلطت دراسة أجراها <A .R. شويدر> وزملاؤه [من جامعة شيكاغو] ـ على مجموعة من الأولاد البرهميين الهندوس في الهند ومجموعة أخرى من الأولاد الذين نشؤوا في بيئة مسيحية يهودية في الولايات المتحدة ـ بعض الضوء على المسألة الثقافية؛ إذ كشفت الدراسة عن وجود تناقضات لافتة للنظر بين المجموعتين. فقد تعلم الطفل الهندي، في سن مبكرة، المحافظة على التقاليد واحترام القواعد المتعارفة فيما يتعلق بالعلاقات بين الأشخاص ومساعدة المحتاجين. أما الأطفال الأمريكيون فقد وُجّهوا نحو الاستقلالية والحرية والحقوق الشخصية. وقال الأطفال الهنود إن أي خرق للتقاليد، كأكل اللحوم أو مخاطبة الأب باسمه الأول، هو أمر يستوجب الشجب بوجه خاص. ولم يروا أي خطأ في أن يردع إنسان ابنه المخطئ أو أن يضرب زوج زوجته عندما تذهب إلى السينما من دون إذنه. في حين استعظم الأولاد الأمريكيون جميع سلوكيات العقاب الجسدي ولم يكترثوا لمخالفات مثل أكل الأطعمة المحرمة أو استخدام أساليب مخاطبة غير لائقة. وفضلا عن ذلك فقد اتخذ الأولاد الهنود والأمريكيون وجهات نظر متعارضة مع تقدمهم في السن. ففي حين حصر الأولاد الهنود الأحكام القيمية في المواقف التي كانت لهم خبرة مألوفة بها، فإن البالغين منهم عمموا قيمهم على مجموعة واسعة من الأوضاع الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، فإن الأولاد الأمريكيين قالوا إن المعايير الأخلاقية ينبغي أن تنطبق على كل فرد دائما، في حين عدّل البالغون القيم في مواجهة الظروف المتغيرة. وعلى ذلك يمكن القول إجمالا إن الهنود بدؤوا الحياة كنسبيين(4) وانتهى الأمر بهم كشموليين(5)، في حين كان اتجاه الأمريكيين هو العكس تماما. على أنه قد يكون من قبيل المبالغة القول إن الأولاد من الثقافات المختلفة يتبنون معايير أخلاقية مختلفة كلية. ففي دراسة شويدر هذه، رأت مجموعتا الأطفال، كلتاهما، أن التصرفات المخادعة (كأن ينكث أب بوعد قطعه لطفله) والتصرفات القاسية (كتجاهل متسول برفقته طفل مريض) هي أفعال خاطئة. كذلك اشتركوا في ازدراء السرقة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وإلحاق الأذى بالضحايا الأبرياء، على الرغم من أنه كان هناك بعض الاختلاف حول ما الذي يشكل ما نعتبره براءة. كذلك يمكننا أن نجد في تلك الأحكام حسا أخلاقيا عاما يقوم على رفض إنساني مشترك. ويعكس هذا الحس قيما أساسية ـ كالخيرية والنزاهة والأمانة ـ تعد ضرورية من أجل تعزيز العلاقات الإنسانية في أغلب المجتمعات التي تعاني اختلالات وظيفية. وقد درس اتجاه بحثي مواز الفروق الجنسوية(6)، وأشار إلى أن الفتيات يتعلمن التأكيد على الرعاية في حين يهتم الأولاد بالقواعد والعدالة. على أن هذه الدعاوى حول الفروق الجنسوية، وخلافا للتنبؤات التي قالت بها النظرية الثقافية، لم تصمد كثيرا. ذلك أن البحث الأصلي الذي زعم أنه لمس فروقا جنسوية افتقر إلى المجموعات الاختبارية الملائمة. نادرا ما اكتشفت الدراسات الجيدة التخطيط التي أجريت على الأطفال الأمريكيين ـ مثل دراسة <L. وولكر> [من جامعة بريتيش كولومبيا) ـ فروقا بين مُثُل كل من الفتيات والصبيان. وحتى بالنسبة إلى البالغين، فعندما يتم ضبط المستويات التعليمية أو المهنية، فإن الفروق تختفي. فالمحاميات لديهن في أغلب الحالات التوجهات الأخلاقية نفسها الموجودة لدى نظرائهن من المحامين، والشيء ذاته يمكن أن يقال بالنسبة إلى العاملين من النساء والرجال في مجال التمريض أو البحث العلمي، إلخ. وكما يقول دعاة النظرية الثقافية فإن هناك تشابها أوضح بكثير بين التوجهات الأخلاقية لدى الذكور والإناث عبر الثقافات. كذلك تحظى الفروق بين الأجيال بقدر ملموس من الاهتمام، وبخاصة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحسرون على ما يعتبرونه انحدارا في الأخلاقيات. ومثل هذه الشكاوى ليست شيئا جديدا بطبيعة الحال(7). ومع ذلك فهناك بعض الشواهد على أن شباب اليوم هم أقرب إلى الانخراط في السلوكيات المناهضة للمجتمع مقارنة بشباب الجيل السابق. فطبقا لدراسة مسحية أجراها <M .T. أكنباخ> و<T .C. هوويل> [من جامعة فيرمونت] ذكر الآباء والمدرسون عام 1989 مشكلات سلوكية (كالكذب والغش) وتهديدات أخرى للتطور السوي (الاكتئاب والانطواء) تفوق ما ذكروه عام 1976 (انظر التوضيح أعلاه)(8). غير أن ثلاثة عشر عاما ليست سوى طرفة عين مقارنة بالمسيرة الطويلة لتاريخ البشرية. وربما عكست التغيرات مشكلة عابرة، مثل الأساليب المفرطة بالتساهل في تنشئة الأطفال، أكثر من كونها اتجاها دائما.
|
وبالفعل كانت ثمة أهمية لِمُثُل الأولاد في الحالتين ولكن ضمن حدودٍ حصرتها مصلحة شخصية ضيقة. فالأولاد الذين أعطيناهم مستطيلات كرتونية تصرفوا بكرم يتجاوز ثلاثة أضعاف كرمهم تجاه بعضهم بعضا مقارنة بالأولاد الذين أُعطوا شيكولاته. ومع ذلك فقط ظل للمعتقدات الأخلاقية قدر من التأثير. فعلى سبيل المثال، كان الأولاد الذين أعربوا في وقت سابق عن إيمانهم بالحلول القائمة على الجدارة («الشخص الأفضل إنجازا للعمل ينبغي أن يحصل على قدر أكبر من الشيكولاته»)، هم الأقرب إلى اتخاذ الموقف المدافع عن عامل الجدارة في الموقف الفعلي لعملية توزيع الشيكولاته. غير أنهم فعلوا ذلك بحماس أكبر عندما تسنى لهم أن يدّعوا أنهم هم أنفسهم كانوا أفضل إنجازا للعمل من رفاقهم. فمن دون هذا الادعاء كان من السهل أن يميلوا إلى استبعاد عامل الجدارة لصالح التوزيع المتساوي.
ومع ذلك، فإن هؤلاء الأطفال نادرا ما تخلوا كلّية عن الإنصاف. ربما يكونون قد تحولوا عن فكرة العدالة إلى أخرى ـ مثلا، من الجدارة إلى المساواة ـ إلا أنهم لم يلجؤوا إلى تبريرات أنانية من قبيل «يجب أن أحصل على مقدار أكبر لأنني كبير» أو «الصبيان يحبون الشيكولاته أكثر من البنات، وأنا صبي.» غير أن تلك المبررات صدرت عن الأولاد الذين أعربوا عن عدم إيمانهم سواء بالجدارة أو بالمساواة كأساس للتوزيع. في حين كان الأولاد الأكبر سنا أقرب إلى الإيمان بالعدل كأساس للتوزيع وإلى التصرف بناء على ذلك، حتى وإن لم يكن هذا التصرف لصالحهم. وقد مثلت هذه النتيجة دليلا يعزز صحة الفرضية القائلة إن المُثل الأخلاقية يمكن أن يتزايد تأثيرها في السلوك مع اطراد نضج الطفل.
افعل الشيء الصحيح(9)
غير أن هذه السيرورة ليست آلية، إذ يتعين على الشخص المعني أن يتبنى تلك المعتقدات كمكون أساسي من مكونات هويته الشخصية. فعندما ينتقل المرء من القول إن «على الناس أن يكونوا أمناء» إلى «أريد أن أكون أمينا»، فإنه يصبح أقرب إلى الصدق في تعاملات الحياة اليومية. وهذا الاستخدام للمبادئ الأخلاقية في تحديد هوية الذات يُسمى الهوية الأخلاقية للفرد. ولا تحدد الهوية الأخلاقية للفرد ما يعتبره الوجهةَ الصحيحة للسلوك فحسب، بل تحدد كذلك لماذا يتعين عليه أن يقرر: «يتوجب عليّ شخصيا أن أسلك هذا المسلك.» وهذا التمييز عامل حاسم في فهم تنوع السلوك الأخلاقي. فالمُثل العامة ذاتها يشترك في تبنيها حتى الأفراد الأصغر سنا في المجتمع، ويبقى الفرق دائما في مدى اللجوء إلى الفعل وفق هذه المُثل.
فمعظم الأولاد والبالغين سيعربون عن إيمانهم بأنه من الخطأ أن نترك الآخرين يعانون، غير أن نسبة محدودة منهم هي التي ستخلص إلى أن عليهم هم أنفسهم أن يفعلوا شيئا فيما يتعلق بقضية مثل التطهير العرقي في كوسوڤو. وهؤلاء هم الذين من المرجح أن يتبرعوا بالمال أو يسافروا إلى البلقان لتقديم المساعدة. إن شواغلهم فيما يتعلق بالمعاناة الإنسانية تحتل موقعا مركزيا في الطريقة التي يفكرون بها في أنفسهم وفي الأهداف التي يرونها لحياتهم، ومن ثم فهم يشعرون بمسؤولية أن يقوموا بفعل شيء ما، حتى وإن كان ذلك يكلفهم شخصيا الكثير.

التهديد الغاضب باستخدام القوة في أحد ملاعب تكساس: يتعلم معظم الأطفال أن السلوك غير المتحيز كثيرا (وإن لم يكن دائما) ما تنجم عنه مشاجرات، وهو درس يساعدهم على النمو أخلاقيا. |
وفي دراسة حول الشخصيات التي تمثل «قدوة» أخلاقية ـ أي هؤلاء الأشخاص ذوو التاريخ الطويل والموثّق علانية في فعل الخير وفي أنشطة الحقوق المدنية ـ صادفتُ مستوى عاليا من التكامل بين تصوره لذاته واهتماماته الأخلاقية. فالأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم بدلالة أهدافهم الأخلاقية من المرجح أنهم يرون العديد من المشكلات الأخلاقية في الأحداث اليومية، كذلك يرجح أنهم يجدون أنفسهم معنيين بالضرورة بتلك المشكلات. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يمثلون قدوة أخلاقية لم يُظْهروا أي دلائل على تفكير أخلاقي أكثر تبصرا. فمُثُلهم الأخلاقية ومستويات «كولبرگ» لديهم لم تختلف كثيرا عنها لدى أي شخص آخر.
وفي المقابل، فإن العديد من الناس يتساوون من حيث وعيهم بالمشكلات الأخلاقية، لكن القضايا تبدو بالنسبة إليهم بعيدة عن حياتهم الشخصية وعن إحساسهم بأنفسهم. فرُواندا وكوسوڤو تبدوان بعيدتين وهامشيتين، وبسهولة تُستبعدان من الذهن. وحتى القضايا الأقرب من بيوتنا ـ مثل زمرة مهووسة من الفتيان تهدد واحدا من رفقائهم في المدرسة ـ ربما بدت مشكلة تخص أي شخص آخر غيرنا. وانعدام الفعل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدركون الأمور على هذا النحو، لا يؤثر في تصورهم عن ذواتهم. لذلك فإن معرفتهم الأخلاقية، بغض النظر عن الافتراضات الشائعة القائلة بعكس ذلك، لن تكون كافية للحث على القيام بعمل أخلاقي.
إن نمو الهوية الأخلاقية يتبع نمطا عاما. وهو يبدأ بالتشكل عادة في الطفولة المتأخرة، عندما يكتسب الأولاد القدرة على تحليل الناس ـ بما في ذلك هم أنفسهم ـ من زاوية سماتٍ شخصية ثابتة. ففي الطفولة، تتألف السمات المحددة للذات عادة من مهارات واهتمامات مرتبطة بالفعل («أنا ذكي» أو «أنا أحب الموسيقى»). ومع تقدم العمر، يبدأ الأولاد باستخدام التعبيرات الأخلاقية في تعريف أنفسهم. ومع بداية البلوغ، يلجؤون بصورة نمطية إلى الاستشهاد بصفات مثل «غير متحيز»، و«كريم» و«أمين».
ويذهب بعض المراهقين بعيدا جدا في هذا الصدد فيصفون أنفسهم من منظور أهداف أخلاقية في المقام الأول. فيتحدثون عن أهداف نبيلة مثل الاهتمام بالآخرين أو تحسين وتطوير مجتمعاتهم المحلية ـ على أنها مهام تضفي على حياتهم معنى. ولقد وجد <D. هارت> وزملاؤه [من جامعة روتجرز بنيوجرسي] خلال بحثهم الميداني بمدينة كامدن، أن نسبة كبيرة ممن يطلق عليهم تعبير «قدوة» في الاهتمام بالآخرين ـ هؤلاء اليافعون الذي يصفهم المدرسون والمديرون بأنهم على درجة عالية من الالتزام بالعمل التطوعي ـ يتمتعون بهويات ذاتية مبنية على أنساق اعتقادية أخلاقية الطابع. ومع ذلك فإنهم لم يسجلوا درجات أعلى من نظرائهم في الاختبارات النفسية القياسية المتعلقة بالحكم الأخلاقي. والواقع إن أهمية هذه الدراسة إنما ترجع بالدرجة الأولى إلى أنها أُجريت في بيئة حضرية محرومة اقتصاديا ووسط مجموعة من المراهقين كثيرا ما نُمِّطوا كأشخاص خطرين وذوي ميول إجرامية [انظر الحوار مع يافع مدينة كامدن، ص 7].

تعبئة وجبة غذائية في أحد مستودعات الغذاء بنيوجيرسي: يمكن للآباء أن يتيحوا المجال لأطفالهم لخوض تجربة العمل مع رفاقهم، التي تغرز ألوانا من التعلم الأخلاقي؛ ومن أمثلة ذلك مشروعات خدمة «المجتمع المحلي» التعاونية. |
وعلى الطرف الآخر من الطيف الأخلاقي، ثمة شواهد إضافية تشير إلى أن الهوية الأخلاقية توجه السلوك. فقد لاحظ <H. ماركوس> [من جامعة ستانفورد] و<D. أويزرمان> [من جامعة ميتشگان] أن الشبان الجانحين لديهم إحساس مبتسر بأنفسهم، وبخاصة عندما يتحدثون عن ذواتهم المستقبلية (وهو جزء حرج من هوية المراهق). فهؤلاء اليافعون المضطربون لا يتخيلون أنفسهم أطباء أو أزواجا، أو مواطنين ممارسين لحق الانتخاب، أو أعضاء في الكنيسة، أو أن لهم أي دور اجتماعي يجسد التزاما بقيمة إيجابية.
لكن كيف يكتسب الشاب، أو لا يكتسب، هوية أخلاقية؟ الواقع إنها سيرورة تدرجية الطابع، تتم عبر آلاف الوسائل الصغيرة: التلقيم المرتد (التغذية الراجعة) من الآخرين؛ ملاحظة تصرفات الآخرين التي إما تحث أو تنفر؛ تأمُّل تجارب المرء الشخصية؛ التأثيرات الثقافية كالأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام. وتتفاوت الأهمية النسبية لهذه العوامل من طفل لآخر.
علموا أطفالكم جيدا
يمثل الوالدان، بالنسبة إلى أغلب الأطفال، المصدر الأول للتوجيه الأخلاقي. وقد أوضح بعض أساتذة علم النفس، من أمثال <D. بومريند> [أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا ببيركلي]، أن الأبوة «الحازمة» تسهّل عملية النمو الأخلاقي للأطفال بثبات أكبر مقارنة بكل الأبوة «المتساهلة» والأبوة «المتسلطة». فالأسلوب الحازم يضع قواعد أسرية ثابتة وحدودا صارمة، لكنه يشجع أيضا المناقشة المفتوحة والتواصل الصريح لتفسير القواعد، ولتعديلها عند توفر المبرر. وعلى النقيض من ذلك يتجنب الأسلوب المتساهل القواعد كلية، في حين ينفذ الأسلوب المتسلط القواعد بصورة مزاجية من قبل الآباء على طريقة «لأنني قلت ذلك.»
ومع أن الأبوة المتساهلة والأبوة المتسلطة تبدوان على النقيض، فإنهما تنحوان فعليا إلى إنتاج أنماط متشابهة من التحكم الضعيف في النفس والإحساس المتدني بالمسؤولية الاجتماعية للأولاد. كما لا يوفر أي من الأسلوبين التطلعات الواقعية والتوجيه الممنهج اللذان يحفزان الأولاد إلى توسيع آفاقهم الأخلاقية. كما يمكن لكل منهما أن يرسخ عادات ـ من قبيل الشعور بأن الأعراف والتقاليد هي شيء آت من الخارج ـ تسهم في كبح تطور هوية أخلاقية. وفي ذلك ما يوضح أن مصادر السلوك الأخلاقي أو اللاأخلاقي في فترة البلوغ ترجع في بعض جوانبها إلى تجارب الطفولة.
ومع اطراد نمو الأولاد، يتزايد تعرضهم لتأثيرات من خارج نطاق الأسرة. على أن العلاقة بين الوالدين وولدهما تبقى أساسية في معظم الأسر، مادام هذا الولد يعيش في المنزل. فتعليق أحد الوالدين على مقطوعة موسيقية صاخبة أو شريط فيديو تسيل فيه دماء كثيرة يظل عادة، عالقا في ذهن الطفل لفترة تمتد طويلا بعد انتهاء تجربة المشاهدة. والواقع إنه إذا كانت برامج وسائل الإعلام مع ما تعج به من مشاهد جنسية أو يكتنفها العنف، ستفسح المجال أمام تغذية أبوية راجعة(10)، فإن فوائدها يمكن أن تفوق كثيرا ما تخلفه من آثار سلبية.
والواقع إن أحد الأشياء الأبعد تأثيرا والتي يمكن للأبوين أن يفعلاها هو تشجيع الأنماط السليمة من العلاقات بين النظراء. ذلك أن خبرات التفاعل مع النظراء يمكنها أن تستحث النمو الأخلاقي من خلال إظهارها للصراع بين تصوراتهم المُسبقة والواقع الاجتماعي. فخلال المناقشات المتعلقة بتقسيم الشوكولاته، بدا أن بعض الطلبة المشاركين في التجربة قد توصلوا إلى أفكار جديدة ـ وأكثر دقة ـ عن العدالة. وفي دراسة متابعة، أثبتنا أن النقاش بين النظراء قد عمَّق وعيهم بحقوق الآخرين. فالأولاد الذين شاركوا بفاعلية في النقاش، فعبروا عن آرائهم واستمعوا في الوقت ذاته إلى وجهات نظر الآخرين، كانوا هم الأقرب بوجه خاص إلى الاستفادة.
وفي فترة المراهقة، يمثل التفاعل بين النظراء عاملا حاسما في تشكيل الهوية الذاتية (تصور الفرد لشخصيته). ومما لا شك فيه أن هذه السيرورة تتضاءل فائدتها في السلوك الاجتماعي الشللي: فهنا سوف يبحث الأولاد، كوسيلة لتأكيد ودعم الإحساس بالذات، عن الرفاق المشابهين لهم في الميول وينبذون الآخرين الذين يبدون كالغرباء بالنسبة إليهم. غير أن التجمع في زُمَر يمكن أن يتطور ـ إذا ما أُبقي ضمن حدود معقولة ـ إلى نمط صداقة أكثر نضجا. لكن ما الذي يمكن للآباء أن يفعلوه في غضون ذلك من أجل الأخذ بيد مراهق يعاني وطأة العزلة أو الاضطهاد. إن أهم نصيحة يمكنهم تقديمها هي أن السلوك الفظ إنما يكشف شيئا عن الجاني وليس عن الضحية. فإذا ما ساعدت هذه النصيحة ذلك الشاب اليافع على مقاومة أن يأخذ المعاملة التي يتلقاها على محمل شخصي، فإن فترة الاضطهاد سوف تمر من دون أن تترك ندوبا نفسية.
ويقوم بعض علماء النفس، بانتهاج مقاربة اجتماعية (سوسيولوجية)، وذلك بدراسة المتغيرات على مستوى المجتمع المحلي؛ ومنها على سبيل المثال، ما إذا كانت التأثيرات الأخلاقية للآباء، للمدرسين ولوسائل الإعلام، إلخ، تتناغم بعضها مع بعض. وفي دراسة أجريت على 311 مراهقا من عشر مدن أمريكية، لاحظ <J.F. ينِّي> [من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا) درجات عالية من السلوك الغَيْري ودرجات دنيا من السلوك المناهض للمجتمع في صفوف اليافعين المنتمين لمجتمعات محلية تتميز بوجود اتفاق في التطلعات بين شبابها.
فجميع الذين يعيشون في تلك الأماكن أجمعوا على أن الأمانة، على سبيل المثال، تمثل قيمة أساسية. فالمدرسون لا يتساهلون مع الغش في الامتحانات، والآباء لا يتركون أطفالهم يكذبون ويفلتون بكذبهم من العقاب، ولا يشجع مدربو الرياضة فرقهم على الخروج عن القواعد من أجل تحقيق الفوز، كما يتوقع الناس من جميع الأعمار الشفافية والصراحة من أصدقائهم. غير أن العديد من المجتمعات المحلية الأخرى بدت منقسمة بشأن تلك الطرائق في السلوك. فقد كان المدربون في هذه المجتمعات يحبذون الفوز قبل أي شيء آخر، واحتج الآباء عندما وبخ المدرسون أبناءهم بسبب الغش أو الأداء المتدني للواجب المدرسي. وفي ظل ظروف كهذه، يتعلم الأطفال ألا يأخذوا الرسائل الأخلاقية على محمل الجد.
وقد سمى <ينّي> مجموعة المعايير المشتركة في المجتمعات المحلية المتناغمة «الميثاق الشبابي»(11). والواقع إنه لا دخل للعرق أو التنوع الثقافي أو الوضع الاقتصادي الاجتماعي أو الموقع الجغرافي وعدد السكان فيما إذا كانت مدينة من المدن قد هيأت لشبانها اليافعين بوصلة(12) أخلاقية ثابتة. فهذا المفهوم المتعلق بالميثاق الشبابي إنما يجري استجلاؤه في التدخلات الاجتماعية التي تعزز التواصل بين الأولاد وآبائهم، ومدرسيهم والأشخاص الكبار الآخرين من ذوي التأثير. وفي الوقت ذاته، سعى باحثون آخرون إلى فهم ما إذا كانت القيم النوعية تعتمد على الخلفية الثقافية أو الجنسوية أو الخلفية الجيلية(13) [انظر ما هو مؤطر في الصفحة 88].
لكن لسوء الحظ، تبدو المفاهيم المتجسدة في المواثيق الشبابية، أندر بصورة متزايدة في المجتمع الأمريكي. وحتى عندما يحدد البالغون موقع الخلل، فإنهم قد يخفقون في التدخل الناجح لمعالجته. فالآباء مشغولون وهم منقطعو الصلة في أكثر الأحيان مع حياة أقران أولادهم؛ ويمنحون أبناءهم استقلالية تزيد كثيرا على ما كانت عليه من قبل، والأبناء من جانبهم يتوقعونها ـ وفي واقع الأمر يطالبون بها. أما المدرسون فيشعرون أن حياة تلامذتهم خارج المدرسة شأن لا يتعلق بهم، وقد يوجه إليهم اللوم ـ بل وقد يتعرضون للمساءلة ـ إذا ما تدخلوا في مشكلة شخصية أو أخلاقية تتعلق بتلامذتهم. كما أن الجيران يفكرون بالطريقة نفسها: إنه ليس من شأنهم التدخل في شؤون أسرة أخرى، حتى وإن رأوا أحد أولاد هذه الأسرة مقبلا على فعل سيئ.
إن مجمل المعرفة التي توصل إليها علماء النفس من دراستهم للنمو الأخلاقي للأولاد يشير إلى أن الهوية الأخلاقية ـ المصدر الأساسي للالتزام الأخلاقي عبر مسيرة الحياة كلها ـ إنما تتعزز من خلال التأثيرات الاجتماعية المتعددة التي توجه الطفل في الاتجاه العام نفسه. وإنه يجب أن يسمع الأولاد الرسالة بما يكفي لكي تترسخ في أذهانهم. ويتمثل التحدي الذي يواجه المجتمعات التعددية(14) اليوم في إيجاد أرضية عامة كافية لتوصيل المعايير الأخلاقية المشتركة التي يحتاج إليها صغار السن.
المؤلف
William Damon
حين كان دامون طالبا في الصف الثامن، كان منضما إلى زمرة من الصبية مارست الاضطهاد والمضايقة على تلميذ لم يكن يروق لأفراد هذه الزمرة. وبعد وصفه لأفعاله في صحيفة المدرسة، قال له مدرس اللغة الإنكليزية «لقد أعطيتك الدرجة النهائية في الكتابة، لكن ما فعلته شيء مخجل بالفعل.» ولقد ظلت هذه التغذية الأخلاقية الراجعة ماثلة في ذاكرته على مر السنين التالية. ويعمل دامون الآن مديرا لمركز دراسات المراهقة التابع لجامعة ستانفورد، وهو برنامج بحثي متعدد التخصصات يُعنى بما أسماه دامون «فترة النمو الأقل والأقل أمانا، والأكثر إخافة وتعرضا للإهمال.» وبحكم تخصصه باحثًا في علم نفس النمو، درس دامون النمو الفكري والأخلاقي، والمناهج التربوية، وتأثيرات الرفاق والتأثيرات الثقافية في الأولاد.
مراجع للاستزادة
THE MEANING AND MEASUREMENT OF MORAL DEVELOPMENT. Lawrence Kohlberg. Clark University, Heinz Werner Institute, 1981.
THE EMERGENCE OF MORALITY IN YOUNG CHILDREN. Edited by Jerome Kagan and Sharon Lamb. University of Chicago Press, 1987.
THE MORAL CHILD: NURTURING CHILDREN’S NATURAL MORAL GROWTH. William Damon. Free Press, 1990.
ARE AMERICAN CHILDREN’S PROBLEMS GETTING WORSE? A 13 -YEAR COMPARISON. Thomas M. Achenbach and Catherine T. Howell in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 32, No. 6, pages 1145-1154; November 1993.
SOME DO CARE: CONTEMPORARY LIVES OF MORAL COMMITMENT. Anne Colby. Free Press, 1994.
THE YOUTH CHARTER: HOW COMMUNITIES CAN WORK TOGETHER TO RAISE STANDARDS FOR ALL OUR CHILDREN. William Damon. Free Press, 1997.
Scientific American, August 1999
(1) Lord of the Flies عنوان رواية مثيرة للفِكر، كتبها وليام گولدينگ عام 1954؛ وتصف بالتفصيل المغامرات الرهيبة لعصابة من الأطفال تتحول تحولا يستوقف النظر من التحضّر إلى البربرية. إنها تعرض نظرة تشاؤمية تُبين، على ما يبدو، أن الإنسان مرتبط غريزيا بالمجتمع، ومن دونه قد يرتد إلى الهمجية. (التحرير)
(2) Conscience versus Chocolate
(3) situational morality
(4) relativist
(5) universalist
(6) gender differences: الاختلافات ما بين الجنسين.
(7) [انظر: – Teenage Attitudes,” by H. H. Remmers”
D. H. Radlder; Scientific American, June 1958; and
;The Origins of Alienation,” by Urie Bronfenbrenner”
Scientific American, August 1974].
(8) ويقوم الباحثان الآن بتحديث دراستهما المسحية المذكورة.
(9) Do the Right Thing
(10) feedback أو تلقيم مرتد.
(11) youth charter
(12) compass
(13) generational background
(14) pluralistic